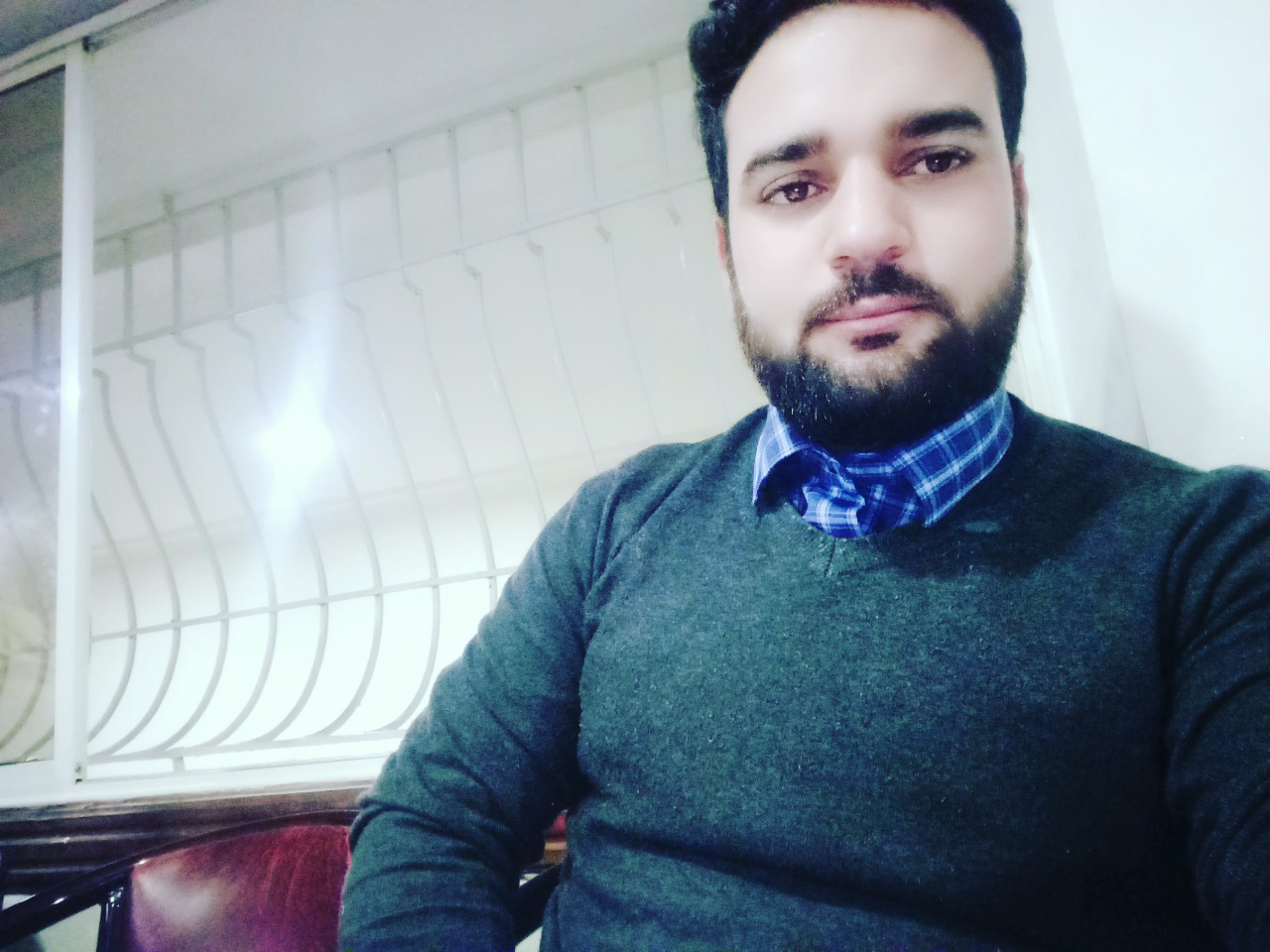خصوصية التعاقد في المجتمع الرقمي
إن التقدم التكنولوجي في وسائل الاتصالات قد أحدث ثورة حقيقية سميت بثورة المعلومات والبيانات نتيجة اجتماع تقنية الاتصالات والمعلومات، وأصبح معها العالم المترامي الأطراف قرية كونية صغيرة تتناقل فيها المعلومات إلكترونيا وبسرعة فائقة عبر شبكة الانترنيت، وقد أسهم ذلك في توسيع دائرة حجم المعاملات بين دول العالم، وظهور أنماط جديدة من التعاقدات والتعاملات لم تكن معروفة من دي قبل، وأضحى العالم في سوق إلكترونية افتراضية تنافسية واسعة تزخر بمختلف السلع والخدمات.
وبفعل التطور التقني لوسائل المعلومات والاتصالات تحول المجتمع من مجتمع تقليدي يعتمد المحرر الورقي إلى مجتمع رقمي يعتمد الدعامة الالكترونية، وهذا التطور التكنولوجي أدى أيضا إلى تغيير العديد من المفاهيم التي كان مسلما بها من قبل، فلم تعد المعلوميات بدعة جديدة، دخيلة على المجتمع، بل أصبحت ضرورة ملحة وواقعا يفرض نفسه بحكم حاجة الإنسان الماسة لها، إذ تعددت أوجه استخدامها فأصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية، نظرا للدور الكبير الذي تقوم به في شتى مجالات الحياة.
ونظرا لأهمية المعاملات الإلكترونية، وتشجيعا لانتشارها، وبث الثقة لدى المتعاملين فيها، فقد تضافرت الجهود الدولية والإقليمية لتذليل ما يعترضها من عقبات، من خلال العمل على تهيئة البنية القانونية التي تتماشى مع خصوصيتها، سواء من حيث إنجازها أو من حيث إثباتها. وعلى نفس المنوال ساير المشرع المغربي الوضع الجديد، استجابة منه لتطلعات المتعاملين المتعطشين للسرعة والفعالية في النظام القانوني، حيث إنه عمل على إصدار ترسانة من القوانين[1]، يبق أهما قانون التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية رقم (53.05)، الذي أفرز من خلاله تنظيما للتعاملات الإلكترونية شملت موضوعين أساسيين، تعلق الأول بوضع البنية القانونية المنظمة لهذه التعاملات، والتي تتمثل أساسا في الاعتراف بالمحررات الإلكترونية، ومساواتها بنظرتها التقليدية، وتشفير البيانات، وكذلك الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني ومعادلته بالتوقيع التقليدي باعتباره دليلا للإثبات، أما الموضوع الثاني، فيتعلق ببث الثقة في هذه التعاملات عن طريق تحديد الإطار القانوني المطبق على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية وكذا القواعد الواجب التقيد بها من لدن مقدمي الخدمة المذكورين ومن لدن الحاصلين على الشهادات الإلكترونية.
هذا الأمر يدفعنا لإثارة إشكالية في غاية الأهمية تتمحور حول: حدود استجابة القوانين الخاصة بالتعاقد عن بعد لخصوصية المجتمع الرقمي؟
وللوقوف على معالجة هذه الإشكالية أعلاه، ارتأينا تقسيم هذا الموضوع الى مطلبين:
المطلب الأول: تمظهرات الرقمنة على مرحلة تكوين العقد.
المطلب الثاني: تأثر مؤسسة الاثبات في ظل التعاقد عن بعد.
المطلب الأول: مظاهر الرقمنة على مرحلة تكوين العقد.
إن انشاء العقد هو تكوينه بين طرفيه، وحتى يكون العقد بصورة صحيحة منتجا لآثاره القانونية، هناك أركان[2] وشروط يجب أن تتوفر فيه، ويعتبر ركن الرضا أهم العناصر الأساسية لتكوينه باعتباره-الرضا -توافق ارادتي المتعاقدين على احداث الأثر القانوني المتوخى من العقد، ويتحقق هذا التوافق قانونا بتبادل التعبير عن ارادتين متطابقتين، ويكون ذلك بصدور ايجاب يتضمن عرضا يوجهه شخصا لآخر، وصدور قبول متطابق للإيجاب من الشخص الذي وجه اليه العرض، فيقترن القبول بالإيجاب ويحصل التراضي وبالتالي ينعقد العقد. بيد أن التطور الحاصل في مجال استخدام شبكات الاتصال الحديثة في توجيه العقود والخصوصية التي تتميز بها، جعل من الممكن إسناد إرادة الأطراف بطريقة إلكترونية في بيئة افتراضية تتلاقى فيها إرادة المتعاقدين عن بعد، الأمر الذي فرض على تشريعات الدول إعادة النظر في وسائل التعبير عن الإرادة العقدية، والمشرع المغربي بدوره نظم أحكام العقد الالكتروني من خلال افراد أحكام خاصة بالإيجاب تحت عنوان «العرض»، وأحكاما خاصة بالقبول تحت عنوان: «إبرام عقد بشكل الكتروني». الأمر الذي سوف نعمل من خلاله تسليط الضوء على خصوصية هاذين العنصرين في العقد الموجه بطريقة الكترونية.
الفقرة الأولى: خصوصية الايجاب في العقد المبرم بطريقة إلكترونية.
قد تفضي المفاوضات التي تتم بطريقة الكترونية -وهي مرحلة سابقة على التعاقد-الى صدور ايجاب الكتروني من أحد الطرفين للآخر معلنا عن رغبته الباتة في ابرام العقد، باعتباره أول عناصر التراضي اللازمة للانعقاد، فهو نقطة البداية التي يؤسس عنها العقد، ولدراسة الايجاب الالكتروني يقتضي منا الأمر (أولا) البحث في تبيان المقصود منه، بعدها نبين شروطه القانونية (ثانيا).
أولا: تعريف الايجاب الالكتروني.
سنتناول في هذا الشق من دراستنا التطرق للمقصود بالإيجاب الالكتروني-وان كان المشرع المغربي اعتمد مصطلح “العرض” الذي سنبين الغاية من ذلك في حينه- من وجهة نظر الفقه و القانون ونرى الخصوصية التي ينفرد بها عن الايجاب التقليدي، وكل ذلك وفق الشكل التالي:
1 – التعريف الفقهي للإيجاب الالكتروني.
يرى جانب من الفقه القانوني بأن الايجاب الالكتروني: “هو تعبير جازم عن الإرادة يتم عن بعد عبر تقنيات الاتصال الحديثة ويتضمن كافة الشروط والعناصر الأساسية للعقد المراد ابرامه، ومن تم ينعقد العقد متى تلاقى مع القبول”[3].
وفي نفس الاتجاه ذهب جانب من الفقه على تعريف الايجاب الالكتروني على أنه: “تعبير عن إرادة الراغب في التعاقد عن بعد، بحيث يتم من خلال شبكة دولية للاتصالات بوسيلة مسموعة مرئية، ويتضمن كل العناصر اللازمة لإبرام العقد بحيث يستطيع من وجه إليه ان يقبل التعاقد مباشرة[4]. في حين يعرفه البعض الآخر أنه:” تعبير عن إرادة مبتدئة جادة موجهة للطرف الآخر لإبرام العقد بوسيلة من وسائل الاتصال الحديثة عن بعد، وتكون ذات تعابير محددة تحديدا تام الدلالة على نية الموجب بالتزام بات لدى القبول”[5].
فمن خلال التعاريف أعلاه يتضح أن السيمة المميزة– بعد إجماع الفقه – في الايجاب الالكتروني، تكمن من خلال أن العقد الالكتروني يتم عن بعد باستخدام وسائل اتصال [6]حديثة [7] ووسائط الكترونية [8]يمكن أن يعتمد عليها الموجب في اسناد ارادته كما بينا سابقا.
والسؤال المطروح هو: هل عرف المشرع المغربي في القانون رقم 53 , 05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الإيجاب الإلكتروني؟
2 – التعريف التشريع للإيجاب الالكتروني.
إن أول ما استرعى اهتمامنا في هذا الصدد هو أن المشرع المغربي لم يتحدث في القانون رقم 53 . 05 عن الإيجاب الإلكتروني بل عن “العرض” وذلك ترجمة للمصطلح الفرنسي offre ‘ L وهو مصطلح اقتصادي و يقابله مفهوم الطلب La demande، أما في القانون فيقابله مصطلح ” القبول L ‘ acceptation ، كما أنه لم يعرف العرض الإلكتروني – الإيجاب الإلكتروني – وهذا الأمر يعتبر عاديا بما أن مسألة التعريفات لا تعتبر من اختصاص التشريع بل من صميم اختصاص الفقه، لكن وبمقابل ذلك فإن المشرع المغربي اعترف بإمكانية استخدام الطرق الإلكترونية في الإيجاب، حيث جاء بهذا الخصوص ضمن الفصل (3- 65) فقرة 1 و 2 من قانون 05 – 53 :”يمكن استخدام الوسائل الالكترونية لوضع عروض تعاقدية أو معلومات متعلقة بسلع أو خدمات رهن إشارة العموم من أجل إبرام عقد من العقود”، الأمر الذي يتضح من خلاله اعتراف المشرع باعتماد الوسائل الالكترونية في التعاقد، وهذا الأمر لا يسعنا إلا أن ننوه به لأنه يواكب تطورات العصر في المجال التكنلوجي والمعلوماتي.
وبناءا على ما سبق فالإيجاب الالكتروني لا يختلف عن الايجاب التقليدي إلا في الوسيلة المستعملة، بحيث يلزم أن يكون جازما وباتا وأن تتوفر النية لدى الموجب لإحداث أثر قانوني، وان يكون كاملا ومحددا تحديدا كافيا بأن يحتوي على الشروط الأساسية للتعاقد.
وعموما وحتى نكون أمام إيجاب إلكتروني فإنه يجب يستجمع مجموعة من الشروط، لكن قبل التطرق لذلك لابد من الإشارة الى أن المشرع اعتبر الايجاب الالكتروني ملزما في حالتين[9]:
*عند اقتران الايجاب بأجل القبول، وفي هذه الحالة يجب التزام الموجب بالعرض المقدم من طرفه الى غاية المدة المحددة لمعرفة إرادة الموجه اليه الايجاب هل سيقبل أو سيرفض؟
*ويظل الموجب ملتزما أيضا بإيجابه في حالة بقاء عرض الايجاب بالوسائل الالكترونية، وتمكن الغير من الولوج اليه وذلك بفعله لا بفعل غيره.[10]
أما عن حالات تحقق العرض فإن المشرع المغربي حدد في الفصل 65-3 من ظهير الالتزامات والعقود ثلاث حالات اعتبرها كلها تدخل في إطار العرض[11]:
_ الأولى: حالة وضع الايجاب، في شكل عروض تعاقدية، أو معلومات متعلقة بسلع أو بخدمات، رهن إشارة عموم الناس، من أجل ابرام عقد من العقود.
_ الثانية: الحالة التي يطلب فيها شخص معين بالذات، معلومات من أجل ابرام عقد.
_الثالثة: عندما يتعلق الأمر بتوجيه معلومات أثناء تنفيذ عقد[12].
ثانيا: شروط وحالات تحقق الإيجاب في العقد الالكتروني.
يعد العرض اقتراح للتعاقد، يتضمن كل تعابير العقد الضرورية، لذلك تطرق المشرع لشروط اعتبرها ضرورية لصحته نظمتها مقتضيات الفقرة 3 من الفصل 65-4 [13] ظهير العقود والالتزامات والتي سوف نتناول اللغة المقترحة من أجل ابرام العقد كأهم عنصر نظرا للدور الذي تلعبه في حماية الأطراف المتعاقدة، ونبين مدى اهتمام التشريعات الأجنبية بها. ثم نتطرق بعد ذلك الى الحالات التي يسقط فيها الايجاب.
1 اللغات المقترحة من أجل ابرام العقد:
في هذه النقطة نتساءل فيما إذا كان من الضروري أن يصدر العرض بلغة معينة، أم أنه يمكن أن يعبر عنه بأي لغة كانت؟
بعض القوانين تشترط استعمال اللغة الوطنية للتعبير عن الايجاب، من بينها القانون الفرنسي الذي نص على ذلك في قانون رقم (665-94) الصادر سنة 1994 والمسمى بقانون توبون”Loi Toubon [14]” في المادة 2 منه التي تجعل من الضروري استمال اللغة الفرنسية، حيث تنص على أنه:” في الوصف، الايجاب التقديم، طريقة التشغيل أو الاستعمال، وصف مجال الضمان الخاص بالمنتج أو الخدمة ، كذلك في الفواتير والإيصالات تكون باللغة الفرنسية وجوياً، وذلك في كل إعلان مكتوب، شفهي أو سمعي مرئي[15]، وعدم احترام هذا الالتزام يترتب عليه توقيع الجزاء القانوني”.
وقد صدر منشور وزاري في فرنسا يوضح الهدف من اشتراط اللغة الفرنسية هو: ضمان حماية المستهلك لكي يستطيع أن يشتري أو يستعمل منتجا أو يستفيد من خدمات وهو يعلم حقيقة طبيعتها، وكيفية استعمالها والشروط الخاصة بالضمان لهذه المنتجات أو الخدمات[16].
وهو نفس الطرح الذي تماشى معه المشرع الجزائري عند اقتصاره على ضرورة اشتراط اللغة العربية أساسا فيما يخص إعلام المستهلك، وذلك في المادة 18[17] من قانون رقم 09-03 لسنة 2009م المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. وهو نفس الأمر الذي حث عليه المشرع المغربي حيث ألزم العارض أن يضمن في عرضه اللغات التي يقترحها من أجل التعاقد، على أن يأتي في قانون خاص وهو المتعلق بحماية المستهلك [18]وينص على ضرورة الاحتكام الى اللغة العربية أو أن تصطحب العقد المحرر بلغة أجنبية ترجمة الى اللغة العربية، وذلك لحماية لرضا المستهلك المفترض فيه طرف ضعيف في العلاقة التعاقدية، لكن الواقع على خلاف ذلك حيث ان العديد من المؤسسات أصبحت تعتمد عقودا تحتال من خلالها على المستهلك تحت وطأة الحاجة والأمية. وإن المشرع قد رتب أثرا في الفقرة الأخيرة من الفصل 65-4 على عدم ادراج هذه العناصر الأساسية في الايجاب، حيث إن هذا الأخير يصبح مجرد إشهار ولا يلزم المستهلك.
وعموما، فإن هذه العناصر التي يجب أن يدلي بها الموجب الإلكتروني أو السيبراني، تعتبر درجة أخرى من درجات الإعلام التي يتمتع بها للمتعاقد الإلكتروني لوحده دون غيره من المستهلكين، وكأن المشرع يحث على الزيادة في إعلام هذه الفئة من المتعاقدين، وذلك لكونهم لا تتاح لهم فرصة تفحص ولمس السلعة أو المنتوج عن قرب.
هذا، وللإيجاب الالكتروني، بالإضافة الى شروطه، قواعد خاصة تتعلق بسقوطه.
- حالات سقوط الايجاب الالكتروني
يعتبر الايجاب الالكتروني منتجا لآثاره، طالما أن من وجه إليه له القدرة على قبوله، لكن هذه المكنة قد تنتهي وبذلك ينقضي الايجاب الالكتروني في الحالات التالية:
أ _ انتهاء المدة المحددة للقبول:
تنتهي العروض بمدة محددة ومعقولة حيث تتفاوت تلك المدة حسب الظروف المختلفة للصفقات الإلكترونية، فالعروض تنتهي بشكل سريع في الأسواق المتقلبة (مثل البضائع التي تعتمد على المخزون)، وذكرنا سابقا أن الحالات التي يقترن فيها الايجاب بمدة محددة من الموجب يضل هذا الأخير ملزما بها الي حين انتهاء تلك المدة [19]، وهو الأمر الذي نستشف معه بمفهوم المخالفة، أنه اذا انقضت المدة دون صدور قبول من الذي وجه إليه العرض، فان هذا الأخير ينقضي بالسقوط، كما أنه إذا صدر قبول بعد سقوط الايجاب اعتبر ذلك القبول إيجابا جديدا [20].
ب _ العدول عن الايجاب
يمكن للموجب أن يعدل عن إيجابه، بشرط ألا يكون قد صدر قبول من الطرف الآخر، وهذا ما يحدث في البيوع التي تتم عن طريق الانترنت، والتي من المتصور فيها أن يطرأ تغيير على أسعار البضائع والخدمات نتيجة ازدياد العرض أو الطلب عليها فيقوم المنتج أو المزود بتعديل إيجابه [21].
ج _ رفض الايجاب
يمكن أن يرفض (متلقي الإيجاب) العرض رفضا مجردا، أو بالرد عليه بأي تصرف يفيد عدم القبول. والمثال على ذلك نجده في الرسائل الالكترونية المرسلة إلى البريد الإلكتروني للأشخاص بدون طلب مسبق، حيث يمكن للمتلقي التعبير عن عدم رغبته في تلقي هذه الرسائل مرة أخرى.
في الأخير بقي أن نشير أن الإيجاب الإلكتروني وحتى ينتج الآثار المتوخاة من وراء إصداره، والمتمثلة في ابرام العقد، فإنه يجب أن يقترن مع إرادة أخرى تصدر عن الموجب له، ويتعلق الأمر بالقبول الإلكتروني. فما هي إذن خصوصيته؟
الفقرة الثانية: خصوصية القبول في العقد الموجه بشكل الكتروني.
إن أحكام القبول الالكتروني لا تختلف كثيرا عن أحكام القبول العادي – كونه هو التعبير عن إرادة من وجه إليه الإيجاب في إبرام العقد على أساس هذا الإيجاب، ويجب لكي ينتج القبول أثره أن يتطابق تماما مع الإيجاب في كل جوانبه وإلا فإن العقد لا ينعقد – سوى في ان القبول الالكتروني يتم عبر الوسائل التقنية الحديثة للاتصال والتي تضفي عليه نوع من الخصوصية تفرز بعض الصعوبات والعوائق لدى المتعاقد، هذه الوسائل الحديثة للاتصال أثرت كثيرا على المفاهيم التقليدية للقبول السائدة في النظرية العامة للالتزامات والعقود، الأمر الذي أعاق- الى حد ما – تطبيق القواعد العامة التقليدية على القبول الالكتروني الذي يتميز بقواعد خاصة به ترجع الى طرق التعبير عنه، وكذا حق المتعاقد في الرجوع عن قبوله بعدما عبر عنه وتم العقد، لهذا ارتأينا العمل على التطرق (أولا) الى مفهوم القبول الالكتروني وخصوصيته مع الإشارة الى مدى اعتبار السكوت دلالة على القبول في العقد الموجه بطريقة الكترونية، على أن نتناول (ثانيا) الحق في الرجوع عن القبول في العقد المبرم بشكل الكتروني.
أولا: مفهوم القبول الالكتروني .
سنعمل في هذا الجانب الى مناقشة تعريف القبول الالكتروني وشروطه (أ) ثم نتطرق الى مسألة السكوت وصلاحيته للتعبير عن القبول الالكتروني(ب).
أ _ تعريف القبول الالكتروني وشروطه:
1 _ تعريف القبول الالكتروني:
ان المقصود بالقبول عموما موافقة الموجب له على الإيجاب الموجه إليه بالشروط الذي تضمنها وبدون تعديل، حيث يترتب عليه انعقاد العقد إذا ما اتصل بعلم الموجب والإيجاب مازال قائما. والقبول الإلكتروني لا يخرج عن ذلك سوى أنه يتم بوسائط الكترونية من خلال شبكة الانترنت. حيث إنه يعتب بأنه ـ القبول الإلكتروني ـ التعبير اللاحق للإيجاب والذي يصدر ممن يوجه إليه هذا الإيجاب، ويحمل إرادة مطابقة لإرادة الموجب، مضمونها الرضا بالعقد المعروض عليه من قبل الموجب بالشروط التي حددها في إيجابه، وبتمام هذا القبول يتم توافق إرادتي المتعاقدين ويبرم العقد، كما يعتبر بأنه التعبير البات عن إرادة الموجب له والذي بصدوره موافقا للإيجاب ومستوعبا لجميع شروطه يتكون العقد بين الموجب والموجب له القابل[22].
وفيما يخص سمات القبول الإلكتروني، فهي مماثلة لسمات القبول العادي حيث يجب أن يكون باتا، ومحددا ومنصرفا لإنتاج آثار قانونية، وذا مصدر خارجي وأن يصدر وقت يكون فيه الإيجاب قائما وأن يكون مطابقا لهذا الأخير، فإذا كان القبول مطابقا للإيجاب ولا يتضمن أية تحفظات أبرم العقد. أما في الحالة التي لا يطابق فيها القبول الإيجاب مطابقة تامة، كأن يزيد فيه أو ينقص عنه فإن ذلك يعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا[23].
وبرجوعنا للقانون رقم 05 – 53 نلاحظ أن المشرع المغربي عالج أحكام القبول الإلكتروني تحت عنوان “إبرام عقد بشكل إلكتروني” ولم يقم بتعريفه، كما أفرد له فصلا واحدا وهو الفصل 65 – 5 الوارد في الباب الأول مكرر الذي تمت إضافته بمقتضى المادة 3 من القانون المذكور إلى القسم الأول من الكتاب الأول من ق . ع . ل . إن التعبير عن القبول الإلكتروني شانه في ذلك شأن الإيجاب الإلكتروني يستلزم شروط لقيامه، وذلك ما سندرسه فيما يلي:
2 _شروط القبول الالكتروني:
لقد أحاط المشرع المغربي القبول في العقد المبرم بشكل إلكتروني بمجموعة من الضمانات لإرساء عناصر العقد وترسيخا لمبدأ الأمن القانوني، كما أن إبرام العقود يستوجب فرض جودة خاصة في النص التشريعي وذلك بأن يقنن بوضوح عناصر التعاملات القانونية، بما فيها ” العقد المبرم بشكل إلكتروني”، وأن يكون القبول مفهوما وواضحا ودقيقا وغير متعارض مع الإيجاب، ولا تطرأ عليه تغيرات متكررة، وقد نص المشرع المغربي على ضمانات القبول الإلكتروني ضمن الفصل 5-[24]65 من ظهير العقود والالتزامات، وهذه الضمانات كالتالي:
– أن يتمكن من أرسل إليه العرض التحقق من تفاصيل الإذن بالقبول الصادر عنه قبل تأكيده، إضافة إلى الثمن الإجمالي الذي يلتزم به، ثم تصحيح الأخطاء المحتملة التي يمكن أن تتسرب إلى الإذن الصادر عنه، ومعنى هذا أنه حتى بعد تأكيد الإذن بالقبول، يمكن للقابل أن يتدارك مختلف الأخطاء التي تسربت إلى إذنه، ومن ثم فإنه إذا تعلق الأمر بغير الأخطاء، كالتراجع عن الإذن مثلا، فإنه يكون غير مقبول[25]، لأن التدارك والتصحيح محصورين في الأخطاء [26]دون سواها؛
– يثبت للقابل على الموجب التزام الأخير بمجرد توصله بالقبول أن يشعر القابل بطريقة الكترونية بتسلمه قبول العرض الموجه اليه وذلك من باب تأكيد التعاقد، والتأخير المبرر في الاشعار ينتج آثاره القانونية[27].
– يصبح المرسل إليه، فور تسلمه العرض، ملزما به، بشكل لا رجعة فيه.
يعتبر قبول العرض وتأكيده والإشعار بالتسلم، متوصلا بها إذا كان بإمكان الأطراف المرسل إليها، وهذا المقتضى هو ما يميز من منظور المشرع المغربي بحيث على أساسه يبرم العقد الإلكتروني بصفة نهائية[28].
وفي هذا الجانب يثار تساؤل، حول مدى صلاحية السكوت كذلالة للتعبير عن القبول الالكتروني؟
ب: صلاحية السكوت للتعبير عن القبول الالكتروني.
يثار التساؤل حول ما إذا وجه شخص إلى آخر إيجاباً عبر بريده الإلكتروني لإبرام عقد معين، ولم يصدر من الطرف الأخر رد، ولا أي تصرف آخر يدل على قبوله، وإنما التزم الصمت، فهل يمكن أن نستنتج من هذا السكوت إرادة منه بالموافقة على قبول الإيجاب؟ الأصل في القواعد العامة أن مجرد سكوت من وجه إليه الإيجاب لا يعد قبولا على أساس القاعدة الفقهية: ” لا ينسب لساكت قول”، ولذلك فإن من يتسلم رسالة إلكترونية عبر بريده الالكتروني تتضمن إيجابا ونص فيها على أنه إذا لم يرد على هذا العرض خلال مدة معينة اعتبر ذلك قبولاً، فإن مستلم هذه الرسالة يستطيع أن يتجاهلها على أساس القاعدة السابقة. وإستثناءا من ذلك ووفقاً للقواعد العامة في ظهير الالتزامات والعقود، فقد نص الفصل 25 منه على أنه: ” عندما يكون الرد بالقبول غير مطلوب من الموجب، أو عندما لا يقتضيه العرف التجاري فإن العقد يتم بمجرد شروع الطرف الآخر في تنفيذه. ويكون السكوت عن الرد بمثابة القبول، إذا تعلق الإيجاب بمعاملات سابقة بدأت فعلا بين الطرفين”[29].
وقد اختلفت آراء الفقه حول إعمال هذه الاستثناءات في العقد الموجه بطريقة الكترونية، فهناك من يرى أن السكوت يصلح للتعبير عن القبول الإلكتروني، وعليه فإنه من يتسلم رسالة الكترونية عبر الانترنت تتضمن إيجابا وتنتهي بعبارة ” إذا لم يصل رد خلال مدة معينة يعتبر ذلك قبولا “، فان الراجح أنه يمكن اعتبار ذلك قبولا في العقود الالكترونية[30].
ويرى اتجاه آخر من الفقه[31] بأنه إذا كان التعبير عن إرادة القبول قد يكون صريحا أو ضمنيا فإن التعبير عن إرادة القبول الإلكتروني لا يكون إلا صريحا، ولا يعتبر ذلك تقييدا لإرادة المتعاقد، وإنما المقصود من ذلك حمايته من ظل البيئة الافتراضية، وبالتالي يرى بأنه لا يجوز أن يكون القبول الالكتروني ضمنيا عن طريق السكوت.
بينما يذهب جانب آخر من الفقه إلى أنه من الصعوبة إعمال الحالات الاستثنائية في النصوص العامة والتي يعتبر فيها السكوت قبولا أو تطبيقها في مجال المعاملات الالكترونية[32]، وعلى العموم يخلص هذا الرأي إلى أنه وفي كل الأحوال ونظرا للطبيعة الخاصة للعقد الالكتروني كونه يتم عبر وسائل الكترونية، فان التعبير عن إرادة القبول الالكتروني لا يكون بالسكوت، وإنما يجب أن يكون صريحاً سواء باستعمال اللفظ الذي يدل مباشرة على المعنى المقصود عن طريق إجراء المحادثة عبر الانترنت، أو كتابة باستخدام البريد الالكتروني.
وفي نظرنا هو الرأي الذي يميل الى الصواب ـ وهو الذي تماشى معه المشرع المغربي ـ لكون البيئة الرقمية تتسم بالتعقيد يجب حتى يستشف رضى القابل استلزام صدور قبول صريح، وأن يكون من أرسل العرض إليه قد تمكن من التحقق من تفاصيل الإذن الصادر عنه ومن سعره الإجمالي ومن تصحيح الأخطاء المحتملة، وذلك قبل تأكيد الإذن المذكور لأجل التعبير عن قبوله.
هذا، ورغم صدور القبول مستجمعا لأركانه وشرائطه، فإن العقد البرم بشكل إلكتروني لا ينعقد إلا بعد انتهاء أجل الحق في الرجوع، هذا الأخير كحق حديث في المغرب يستلزم التطرق إليه بشكل مقتضب.
ثانيا: حق في الرجوع عن القبول في العقد المبرم بشكل الكتروني.
كما هو متعارف عليه في ظل القواعد العامة التي تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فان أياً من طرفيه لا يستطيع أن يتراجع عنه عند تطابق الإيجاب والقبول، ومن ثم يصبح تنفيذه لازما، ولا يملك أي من المتعاقدين الحق في إنهائه أو تعديله دون المتعاقد الآخر، استناداً إلى الفصل 230 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي الذي ينص على أن: “الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون: ” فالالتزام الناشئ من العقد يعادل في قوته الملزمة، الالتزام الناشئ من القانون، بمعنى أنه إذا كان لا يجوز للشخص أن يتحلل من التزام فرضه القانون، فانه أيضاً لا يجوز أن يتحلل من التزام أنشأه العقد كان هو طرفا فيه، وكما أنه لا يجوز لأحد المتعاقدين بإرادته المنفردة أن ينقض العقد أو ينهيه، أو يعدل فيه، فانه لا يجوز أيضاً للقاضي أن يفعل شيئاً من ذلك، وهذا ما يعبر عنه بالقوة الملزمة للعقد.
لكن التشريعات المتعلقة بالمعاملات الالكترونية أجازت للمتعاقد الرجوع عن عقد أبرمه بالوسائل الإلكترونية، وهذا يعد تمردا وخروجا عن القواعد العامة، اذ أن هذه التشريعات لم تعد تعتبر أن القبول هو نهاية المطاف في إبرام العقود عبر الوسائط الالكترونية.
وقد ظهر الحق في التراجع في التشريع المغربي لأول مرة مع القانون رقم 31 . 08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، حيث ألزم مشرعه على المورد “التاجر السيبراني” أن يسلم للمستهلك شيئا مطابقا لما تم الاتفاق عليه أو لما شاهده عبر شبكة الانترنت، إلا أنه من الناحية العملية قد يفاجئ المستهلك بعدم التطابق شكلا وموضوعاً مع ما اتفق عليه مما يؤدي الى خيبة أمله[33]، لذلك أشار المشرع المغربي في ديباجة القانون رقم 08 – 31 إلى أن حق المستهلك في الرجوع بصفة عامة يعد من الحقوق الأساسية التي كرسها القانون لحمايته ،ثم عاد في المواد 36 ، 37، 38 ، من القانون المشار إليه وأكد على هذا المقتضي في إطار العقود المبرمة عن بعد[34]، وحدد الآجال التي على المستهلك أن يمارس هذا الحق- الرجوع- تحت طائلة سقوطه بالتقادم وذلك بمقتضى المادة 36 [35]من هذا القانون، وحسب هذه المادة فان العقد لا ينفذ قبل انقضاء مهلة الرجوع، ويمكن القول حسب بعض الفقه أن العقد في حقيقته ليست له قوة إلزامية إلا ابتداءاً من الأجل الذي يمكن أن يكون فيه قابلا للتنفيذ، حيث أن هناك فرق بين تكوين العقد وفعاليته، فتوافق الإرادتين يؤدى إلى انعقاد العقد، ولكن حماية للمستهلك يوقف المشرع فعاليته بأن لا ينفذه المستهلك قبل مضي مدة معينة تسمى مهلة الرجوع أو مهلة التروي، فإذا انتهت المدة ولم يمارس المستهلك حقه في الرجوع، اكتسب العقد الفعالية بتنفيذه وإذا مارسها ترتب على ذلك انتهاء العقد وليس بطلانه.
وعند ممارسة المستهلك لحقه في الرجوع، ووفقا لما يستفاد من المادة 37 من قانون 31 – 08، فإنه يجب على المورد أن يرد الى المستهلك المبلغ المدفوع كاملاً على الفور وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة عشر يوما الموالية للتاريخ الذي تمت فيه ممارسة الحق المذكور، وتترتب بقوة القانون، على المبلغ المستحق فوائد بالسعر القانوني المعمول به، أما فيما يخص المادة 38[36]من نفس القانون قد بينت أن حق الرجوع يتعطل ولا يمكن ممارسته إلا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك في بعض الالتزامات والتي يتحمل فيها المستهلك نصيبا في نشوئها[37].
وفي الأخير نشير إلى أن الحق في الرجوع يحث المورد – التاجر – على بذل جهده في أن تكون دعايته للمنتج مطابقة للحقيقة تماما وواضحة، ويحد من نسبة الإغراءات التي تدفع المستهلك للتعاقد دون ترو كاف.
إن حديثنا عن خصوصية التعاقد في المجتمع الرقمي من خلال مرحلة إبرام العقد الإلكتروني، لا تقتصر على مسألة التراضي فحسب بل تتعداها لتشمل مسالة تتعلق بتأثر مؤسسة الاثبات في ظل التعاقد عن بعد أيضا، وذلك ما سنتطرق له في المطلب الموالي:
المطلب الثاني: تأثر مؤسسة الاثبات في العقد المبرم بشكل الكتروني.
لاشك في أن أهمية وسائل الإثبات لا تخفى، ولا حاجة الى التدليل على دورها في حياة الناس، إذ يكفي أن نشير إلى أنها هي الوسائل التي تمكن القضاء من القيام بمهمته في تحقيق العدالة وصيانة المجتمع عن طريق إيصال الحقوق لأصحابها [38]، وقد أدى التطور التكنلوجي الذي عرفته تقنية الاتصال الى ظهور نوع جديد من المحررات، تبرم عبر الشبكة العالمية للاتصالات ويطلق عليها اسم المحررات الالكترونية، هذه المحررات أدت الى ظهور مجموعة من الإرهاصات المتعلقة بإثبات المعاملات الالكترونية، مما أضحت معه الاستجابة لخصوصية التعامل الالكتروني ـ في ظل مجتمع رقمي ـ على مستوى قواعد الاثبات ضرورة ملحة، وهذه الاستجابة لن تتأتى إلا بتطوير المفاهيم التقليدية للدليل الكتابي بحيث يشمل كل الحوامل والدعامات غير الورقية، وقد أظهر المشرع المغربي إصرارا نحو تبني استراتيجية سليمة في التعامل مع تحديات القانون في عصر التقنية، فالمتتبع يلاحظ أن هناك مجموعة من التشريعات ذات الصلة الوثيقة بالمعاملات الإلكترونية، وقد صدرت استجابة من المشرع المغربي للتطور المذهل الذي تعرفه تلك المعاملات، إضافة إلى أن المغرب قد ارتبط بمجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تلزم القضاة باعتماد وسائل الاتصال الحديثة في مجال الإثبات، والملاحظ أن هذه الحلول تندرج في إطار نظرية عامة تقيم التكافؤ بين المحررات الإلكترونية والمحررات الورقية، كما تشكل أرضية مساعدة نحو تشريعات جديدة للمعاملات الإلكترونية أكثر ملاءمة لتحديات المجتمع الرقمي. هذا الأمر سعى بالمشرع المغربي من خلال بعض القوانين أن يبرهن بالملموس أنه مصر على الانتقال من مرحلة التعامل الورقي إلى مرحلة التعامل الإلكتروني[39]، وخلق بيئة قانونية ملائمة للتطورات التقنية في المعاملات الالكترونية وهو ما يتمظهر من خلال القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، الذي ينظم بالأساس المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق وتلك المعدة على دعامة الكترونية[40]، وعلى التوقيع الالكتروني.
ولمناقشة هذا المحور ارتأينا أن نتناول خصوصية الاثبات في المعاملات الالكترونية من الجوانب التالية، حيث سوف نتطرق في (الفقرة الأولى) إلى خصوصية المحرر الالكتروني وحجيته في الاثبات، على أن نتطرق في (الفقرة الثانية) لخصوصية التوقيع الالكتروني وحجيته في الاثبات.
الفقرة الأولى: خصوصية المحرر الالكتروني وحجيته في الاثبات.
في هذا الجانب سوف يتم الحديث عن مفهوم المحرر الالكتروني وعن الشروط اللازم توافرها فيه (أولا)، على أن نعقبه بالحديث عن حجيته في الإثبات ( ثانيا).
أولا: مفهوم المحرر الالكتروني وعن الشروط اللازم توافرها فيه.
تلزمنا معالجة هذا الجانب من دراستنا الوقوف عند مفهوم المحرر الالكتروني تشريعيا (أ) وكذا الوقوف على الشروط اللازم توفرها في المحرر الالكتروني حسب مقتضيات القانون 53.05 (ب).
أ _ مفهوم المحرر الالكتروني.
يعتبر الدليل الكتابي من أهم أدلة الاثبات في القانون المغربي، إذ يمتاز على غيره من الأدلة بإمكانية إعداده منذ نشوء الحق وقبل قيام النزاع، كما أن الدليل الكتابي لأطراف العقد عدة ضمانات من أهمها، أنه يضبط الحقوق القائمة بينهم سواء قبل النزاع أو بعده، إضافة الى أن الكتابة أقل تعرضا لتأثير عوامل الزمن، ولعل هذا هو أساس تغليب جل التشريعات الوضعية الإثبات عن طريق الكتابة[41].
أما بخصوص المحررات الإلكترونية، فالمشرع المغربي أغفل إعطاء تعريف أو تحديد مفهوم لها، واكتفى بشروط إصدار هذه المحررات وإجراءاتها الشكلية وهو نفس الأمر الذي نهجه القانون المدني الفرنسي، بخلاف القانون التونسي الذي عرفها في الفصل 453 مكرر من (ق.ع.ل) على الشكل التالي: “الوثيقة الإلكترونية هي الوثيقة المتكونة من مجموعة أحرف وأرقام أو أي إشارات رقمية أخرى بما في ذلك تلك المتبادلة عبر وسائل الاتصال تكون ذات محتوى يمكن فهمه ومحفوظة على حامل إلكتروني يؤمن قراءتها والرجوع إليها عند الحاجة”[42]، كما عرفته المادة 2 من قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية لسنة 2001 المحرر الإلكتروني بأنه : “معلومات يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل الكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل الالكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني أو البرق التلكس أو النسخ البرقي”، وجاء أيضا في نص المادة 1 / ب من قانون تنظيم التوقيع الالكتروني المصري أن المحرر الالكتروني:” هو رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن، أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة “، وأيضا عرفه المشرع الإماراتي في المادة 2 من قانون المعاملات والتجارة الالكتروني على أنه:” سجل أو مستند يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط ملموس أو على أي وسيط الكتروني آخر يمكن فهمه”.
وعلى العموم يمكن تعريف المحرر الالكتروني بانه:” مجموعة من الحروف أو الأرقام أو الكلمات أو الذبذبات المغناطيسية والرموز التي تعبر عن معنى محدد دقيق، والمحملة على دعائم الكترونية، حتى لو لم تظهر بصورة مادية محسوسة أو مجردة للقارئ ودون الاستعانة بوسائط أخرى مادية. وبناءا على هذا التعريف يثار تساؤل حول كيفية تعامل القاضي رجل القانون على تحميل وتفكيك ذلك المحرر الرقمي ومعرفة مضمونه وإسناده لحامله وتحقيق أمن معلوماتي؟ وهل الاعتماد على مؤسسة الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق التي يستأنس بها القاضي أملا في الوصول الى الحقيقة القضائية الضائعة أمرا اختيارا في الاثبات الرقمي أم أنها أصبحت تقريرية إلزامية تكاد تكون جوهر القناعة القضائية؟ كلها أسئلة توضح مدى تأثير المعاملات الالكترونية على مؤسسة القضاء والجهات المتداخلة معها.
ب _ الشروط اللازم توفرها في المحرر الالكتروني.
أجمعت التشريعات التي اهتدت إلى تنظيم التعامل الإلكتروني، على أن الكتابة من الشروط الأساسية لصحة المحرر الإلكتروني، وهو النهج الذي سار عليه المشرع المغربي من خلال قانون رقم 05. 53 حيث نص من خلال المادة الثانية خاصة في فصلها 1 – 2 على أنه لا بد أن يتم تحرير المحرر الإلكتروني، ومفاد كلمة تحرير ما هو إلا الكتابة، وهذا ما أكده الفصل 1 – 417 من نفس القانون[43]، ومن أجل معادلة الوثيقة الالكترونية بالوثيقة الورقية يتعين توفر شرطين أساسيين أتى على ذكرهما المشرع المغربي في الفصل 1 – 417 [44](ظ.ل.ع) هما:
_ 1 التحقق من هوية الشخص مصدر الوثيقة الالكترونية: والهدف من هذا الشرط هو جعل الشخص الذي صدرت عنه الوثيقة مسؤولا عنها قانونا وواقعا، لكن مادامت هناك إمكانية أن تصدر الوثيقة عن شخص وتنسب إلى آخر في حالة التزوير مثلا فإن المشرع المغربي وكحل لهذه الإشكالية، استعمل عبارة ” الشخص الذي صدر عنه ” وليس عبارة ” الشخص الذي نسبت إليه”، لكن الإشكال يظل قائما عندما يقوم صاحب التوقيع بتسليم مفتاح التشفير لغيره، ويصدر هذا الأخير وثيقة إلكترونية بواسطة ذلك المفتاح فهنا تنسب الوثيقة من الناحية القانونية إلى صاحب التوقيع[45]، ولعل ذلك يعني أن التوقيع هو نسبة ما ورد في المحرر لأطرافه، ويعبر عن قبول الشخص الموقع للالتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورة، فالتوقيع الإلكتروني الموثق وفق ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف، يكون علامة مميزة لشخص الموقع ويرتبط به ارتباطا وثيقا، وبالتالي يشير إلى شخص الموقع بشكل لا لبس فيه ولا أي غموض، ويحدد هويته، وتحديد هوية مبرم العقد أو صاحب الوثيقة أمر ضروري خاصة في مجال الوفاء بالالتزامات العقدية ليتم تحديد أهلية صاحب التوقيع، إذ لا يتصور أن يتم منح شخص عديم الأهلية أو ناقصها توقيعا الكترونيا.
2 _ إعداد الوثيقة وحفظها وفق شروط تضمن سلامتها وتماميتها: إن المشرع المغربي لم يوضح المقصود بالتمامية، بل اكتفى باشتراط أن تكون الوثيقة الالكترونية معدة ومحفوظة ضمن ظروف تضمن تماميتها، لكن بالرجوع لقانون الأونسترال النموذجي نجده في المادة الثامنة منه يبين بأن المقصود بالتمامية هي سلامة المعلومات الواردة في المحرر الالكتروني دون أن يلحقها أي تغيير في شكلها الأصلي الذي نشأت به، ويتم الاحتفاظ بمعلومات المحرر الالكتروني، ويمكن حفظ هذه المحررات إما في الشريط المغناطيسي أو داخل الأقراص المرنة، أو داخل الأقراص الصلبة[46]. كذلك نجد المشرع التونسي في الفصل 4 من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية، قانون عدد 83 مؤرخ في وشت 2000، حيث جاء فيه: “يعتمد حفظ الوثيقة الالكترونية، كما يعتمد حفظ الوثيقة الكتابية. ويلتزم المرسل بحفظ الوثيقة الالكترونية في الشكل المرسلة به ويلتزم المرسل إليه بحفظ هذه الوثيقة في الشكل الذي تسلمها به، ويتم حفظ الوثيقة الالكترونية على حامل إلكتروني يمكن من:
– الاطلاع على محتواها طيلة مدة صلاحيتها.
– حفظها في شكلها النهائي بصفة تضمن سلامة محتواها.
– حفظ المعلومات الخاصة بمصدرها ووجهتها وكذلك تاريخ ومكان إرسالها واستلامها.”
ثانيا: حجية المحرر الالكتروني في الاثبات.
إن قبول القضاء للتعاقدات الالكترونية[47]، يتطلب إقرارا لحجية المستخرجات والمراسلات الالكترونية وضمانا لموثوقيتها كبينة في المنازعات القضائية، وقد تضمنت التشريعات الوطنية والدولية المنظمة للتجارة الالكترونية بوجه عام، وقوانين الإثبات بوجه خاص، قواعد تقضى بالمساواة في القيمة القانونية بين المحررات التقليدية والالكترونية.
وقررت عدة تشريعات معايير للحجية تقوم على إثبات حصول الاتصال وموثوقية المتصلين. وفي هذا الصدد حين المشرع المغربي مقتضيات القانون المدني في باب الإثبات، واعترف قانونيا بالمحرر الالكتروني، ووفق هذا التعديل أعطى للمحرر الالكتروني نفس القوة الثبوتية التي تتمتع بها المحررات الكتابية العادية[48]، وذلك بمقتضى قانون 05 – 53، الذي تمم الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من ظهير العقود والالتزامات المتعلق بالالتزامات بوجه عام وكذا الباب السابع من نفس القسم المتعلق بالإثبات بالكتابة.
فبمقتضى التعديل الأول أضيف الفصل 2 – 1 الذي نص في فقرته الأولى على أنه: “عندما يكون الإدلاء بالمحرر مطلوبا لإثبات صحة وثيقة قانونية، يمكن إعداد هذا المحرر وحفظه بشكل الكتروني”، أما الإضافة الثانية فقد شملت الفصل 1 – 417 الذي جاء في فقرته الأولى أنه: “تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة الكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق”.
وفي الأخير لابد من الإشارة إلى أن الكتابة الإلكترونية عنصر ضروري في المحرر الإلكتروني حتى يكون حجة بين أطرافه[49]، إلا أن هذه الكتابة الإلكترونية ليست كافية حتى يكون للمحرر الإلكتروني حجية، بل لابد من توفر عنصر التوقيع الإلكتروني[50].
الفقرة الثانية: خصوصية التوقيع الالكتروني وحجيته في الاثبات.
التوقيع هو تعبير عن إرادة الموقع ويعد أهم عنصر في الدليل الكتابي الكامل سواء اكان ورقة رسمية أو عرفية[51]، فهو الشرط الجوهري المتطلب لصحة المحررات المعدة للإثبات، حيث أنه يسمح بنسبة المحرر إلى موقعه ولو كانت الكتابة بخط غيره، كما يبرز رضا صاحبه ونيته في التعاقد وينسب الورقة إلى من يراد الاحتجاج عليه بها، وبدونه لا يمكننا الحديث إلا عن مجرد مشروع ورقة يمكن الاعتداد بها كما يمكن التخلي عنها،- بداية حجة- خاصة وأن الكتابة بذاتها ولو كانت بخط صاحبها لا تلزمه في شيء ولا تصلح في أحسن الأحوال إلا كبداية حجة كتابية يتعين البحث عن دليل أخر يدعمها[52]، وحدد المشرع المغربي من خلال القانون المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، وذلك في القسم الثاني منه خاصة الباب الأول والثاني، حيث نجده يتحدث عن التوقيع الالكتروني المؤمن والتشفير ثم المصادقة الالكترونية، والتي من شأنها أو بفضلها يتمتع التوقيع الالكتروني بقوته الثبوتية.
ولدراسة خصوصية التوقيع الالكتروني وحجيته في الإثبات، سوف نتطرق الى ماهية التوقيع الالكتروني (أولا)، وذلك من خلال تحديد تعريفه القانوني وكذا تحديد شروط صحته، ثم صوره وأشكاله من جهة أخرى. على أن نتحدث (ثانيا) عن الحجية القانونية للتوقيع الالكتروني.
أولا: ماهية التوقيع الالكتروني.
إن المفهوم التقليدي للتوقيع أصبح يعرقل سير الإجراءات والمعاملات التجارية التي تتم بسرعة، بحيث اتجه الواقع العملي إلى إدخال طرق ووسائل حديثة في التعامل لا تتفق مع فكرة التوقيع ومفهومها التقليدي، إذ لم يعد مجال للإجراءات اليدوية في ظل مجتمع رقمي تنتشر فيه نظم المعالجة الآلية للمعلومات[53]. فبيئة التجارة الالكترونية أوجدت وسائل تتفق وطبيعتها الخاصة، ومن هنا وجدت وسيلة التوقيع الالكتروني أو التوقيع الرقمي لتحقيق وظيفة التوقيع العادي، وللوقوف على هذه التقنية الجديدة للتواقيع وما يصاحبها من لغط واشكال ناتج عن كثرة التعريفات والتحديدات التي أعطيت لها، سنتطرق في هذا الجانب الخاص بالتوقيع الالكتروني إلى مختلف التعاريف التي أعطيت لهذا النوع من التواقيع وشروط صحته (أ)، تم ننتقل إلى إيراد الصور والأشكال التي يتخذها في حقل المعاملات الإلكترونية (ب).
(أ): تعريف التوقيع الإلكتروني وشروط صحته.
*التعريف:
يعرف التوقيع الإلكتروني بانه ذلك التوقيع الناتج عن إتباع إجراءات محددة تؤدي في نهاية المطاف إلى نتيجة معينة معروفة مقدما، ويكون مجموع هذه الإجراءات هو البديل الحديث للتوقيع بمفهومه التقليدي أو ما يسميه البعض توقيع إجرائي[54]،ويمكن تعريف التوقيع الالكتروني وفق ما جاءت به المادة الثانية الفقرة الأولى من قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية لسنة 2001 بانه: “بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا، ويجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات وبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات”.
وعلى صعيد التشريعات الوطنية نجد القانون البحريني، فقد عرفه في المادة الأولى من قانون التجارة الالكترونية لسنة 2002، بأنه:” معلومات في شكل إلكتروني تكون في سجل الكتروني أو مثبتة أو مقترنة به منطقيا، ويمكن للموقع استعماله لإثبات هويته “.
اما بخصوص المشرع المغربي فإنه سار على عكس التشريعات فلم يعرف التوقيع الالكتروني واكتفي في قانون (35.05) المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية بتبيان المقصود بآلية إنشاء التوقيع الالكتروني المؤمن وحصرها في معدات أو برمجيات يكون الغرض منها توظيف معطيات لإنشاء التوقيع الالكتروني التي تتضمن العناصر المميزة الخاصة بالموقع كمفتاح الشفرة الخاصة بالمستخدم[55]، كما قام بتحديد الشروط التي يجب توافرها في التوقيع الالكتروني المؤمن حتى يتم الاعتداد به.
*شروط صحة التوقيع الالكتروني المؤمن.
كما سبقت الإشارة فالمشرع المغربي لم يعرف التوقيع الإلكتروني[56]، لكنه في المقابل عمل على إدراج شروطه، وحتى يكون التوقيع الإلكتروني مؤمنا صحيحا يجب أن يستوفي الشروط الواردة في المادة 6[57] من قانون (53.05) وهي كالتالي:
_ أن يكون خاصا بالموقع[58].
_ أن ينشا بوسائل يمكن للموقع الاحتفاظ بها تحت مراقبته الخاصة بصفة حصرية، والمقصود بوسائل إنشاء التوقيع، بالمعدات والآليات والتي تكون في شكل رموز، أو حروف، أو أرقام، أو إشارات، حيث تتضمن عناصر مميزة خاصة بصاحب التوقيع، لاسيما وأن المشرع أورد مفتاح الشفرة الذي يجب أن يحتفظ به صاحب التوقيع تحت عهدته ومسؤوليته مثالا لها، ومن هنا فإن وسائل أو آليات إنشاء التوقيع، هي غير آليات إنشاء التوقيع التي يستخدمها الموقع، وقد ميزت بينهما المادة الثامنة [59]بش كل واضح، عندما اعتبرت أن الغرض من آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني هو توظيف معطيات إنشاء ذلك التوقيع[60].
_ أن يضمن وجود علاقة بالوثيقة المرتبطة به، بطريقة تؤدي إلى كشف كل تعبير ألحق بها[61].
_ أن يوضع بواسطة وسائل التوقيع الإلكتروني، تكون صلاحيتها موثقة بشهادة المصادقة.
_ أن يشار في شهادة المصادقة الإلكترونية المؤمنة إلى معطيات التحقق من التوقيع الإلكتروني المؤمن.
ب: صور وأشكال التوقيع الالكتروني.
تختلف التقنيات المستخدمة في تشغيل منظومة التوقيع الالكتروني فهناك تقنيات تعتمد على منظومة الأرقام أو الحروف أو الإشارات وأخرى تعتمد على الخواص الفيزيائية والطبيعية والسلوكية للأشخاص، وقد أدى هذا الاختلاف إلى ظهور صور مختلفة للتوقيع الالكتروني يبقى أبرزها التوقيع الرقمي والتوقيع البيومتري والتوقيع الكودي.
*التوقيع الرقمي
التوقيع الرقمي هو ذلك التوقيع الذي يتم إنتاجه باستخدام تقنيات علم التشفير، ويقوم على فكرة الرموز السرية والمفاتيح غير المتناسقة[62]، وهو أيضا عبارة عن رقم سري أو رمز ينشئه صاحبه بحيث لا يمكن لأحد كشف الرسالة إلا الشخص الذي يحمل مفتاح فك التشفير والتحقق من أن تحويل الرسالة تم باستخدام المفتاح الخاص إضافة إلى التحقق من أن الرسالة الواردة لم يلحقها أي تغيير أو تعديل، ويستخدم هذا التوقيع في المراسلات الإلكترونية بين التجار أو بين الشركات، ومن مزاياه أنه يعد دليلا على الحقيقة بدرجة أكثر من التوقيع التقليدي باعتبار التقنية العالية المستخدمة فيه والتي تفوق في ذكائها وجاهزيتها العقل البشري بأضعاف كثيرة وهو ما يجعل هامش الخطأ أو التزوير قليل وإلى أبعد الحدود، كما يسمح بإبرام الصفقات عن بعد، دون الحضور المادي لطرفي العلاقة وهو بذلك يساعد في تنمية وتوسيع مجال معاملات التجارة الإلكترونية.
والتشفير هنا يتم باستخدام مفتاحين أحدهما للتشفير ويسمى المفتاح الخاص، والثاني لفك التشفير ويسمى المفتاح العام لذلك اصطلح على تسمية هذا النظام بنظام المفتاح العام[63].
*التوقيع البيومتري
يقوم هذا التوقيع على حقيقة علمية مفادها أن سمات الإنسان الفزيائية والطبيعية والسلوكية تختلف من شخص لآخر، وتتميز بالثبات النسبي الذي يجعل لها قدرا من الحجية في التوثيق والإثبات، وعليه يعمل التوقيع البيومتري على التحقق من شخصية الفرد وتحديد هويته باستخدام صفاته الفيزيائية والطبيعية والسلوكية، وهذه الصفات متعددة لكن أهمها يبقى البصمة الشخصية، التعرف على الوجه، مسح العين، خواص اليد، التحقق من نبرة الصوت، . . .الخ[64].
ويتم التحقق من شخصية المستخدم أو المتعامل مع هذه الطرق البيومترية، عن طريق أجهزة إدخال المعلومات إلى الحاسب الآلي، التي تقوم بالتقاط صورة دقيقة لأحد هذه الخواص، ويتم تخزينها بطريقة مشفرة في ذاكرة هذا الأخير، ليقوم بعد ذلك بمطابقة صفات المستخدم مع هذه الصفات المخزنة، ولا يسمح له بالتعامل أو الولوج إلا في حالة المطابقة.
*التوقيع الكودي:
يتم توثيق التعاملات الإلكترونية بطريقة التوقيع الكودي أو السري وذلك باستخدام مجموعة من الأرقام أو الحروف أو كليهما، يختارها صاحب التوقيع لتحديد شخصيته ولا تكون معلومة إلا منه هو، ومن يبلغه بها [65]ويطلق على هذا التوقيع أيضا تسمية التوقيع من خلال البطاقة الممغنطة، وذلك لارتباطه بالبطاقات الممغنطة، وينتشر استعمال هذه الطريقة في عمليات البنوك والدفع الإلكتروني بصفة عامة.
وفي الأخير نستنتج أن التوقيع الإلكتروني بصفة عامة يستطيع أن يؤدي نفس الأهداف التي يؤديها التوقيع العادي حيث تتوافر فيه إمكانية تحديد هوية الشخص الموقع، كما أنه يصلح لإسناد رضائه للالتزام بمضمون التصرف، وكذلك المحافظة على تمامية المضمون، وذلك بفضل التقنيات المستخدمة في تأمين مضمون المحرر الإلكتروني، وتأمين ارتباطه بشكل لا يقبل الانفصال عن التوقيع، مما يضفي الأمان على المعاملات الإلكترونية ويساعد على ازدهارها وتطورها، هذا الأمر سيقودنا مباشر للتساؤل حول حجية التوقيع الالكتروني المؤمن في المعاملات الالكترونية؟
ثانيا: الحجية القانونية للتوقيع الالكتروني.
عندما يبرم الأطراف عقودا بطريقة الكترونية فإنهم يوقعون عليها توقيعا الكترونيا، كما أن أية مراسلات تتم بينهم لابد وأن تكون موقعة الكترونيا أيضا، وعليه لا بد وأن نتعرض لحجية التوقيع الالكتروني للأطراف في مواجهة بعضهم البعض، وكذا لدى الجهات القضائية المتنازع أمامها.
وإذا كان الهدف من موجة التشريعات الحديثة هو تسهيل استعمال الوسائل الالكترونية في المعاملات التجارية، فإن أبرز صور هذا المد التشريعي جاءت بالأساس لتحيين أنظمة الإثبات في القوانين المدنية المعاصرة، كما أن أسمى أهداف مواءمة أنظمة الإثبات مع متطلبات التجارة الالكترونية هو الاعتراف القانوني بالوثيقة الالكترونية وإعطاءها نفس الحجية القانونية التي تتمتع بها الوثيقة الكتابية العادية[66]. والمشرع المغربي بدوره نهج على غرار باقي التشريعات نهجا إيجابيا، من خلال إصداره لقانون التبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، الذي تطرق من خلاله، إلى معالجة التوقيع الالكتروني، وضرورة توافر شروطه، حتى يتمتع بالحجية وبالتالي اعتماده كأداة من أدوات الإثبات القانونية[67].
خاتمة
حاولنا من خلال هذا البحث، التي يعالج موضوعا في غاية الأهمية أن نتوصل قدر الإمكان، لمناقشة الاشكالات ذات القيمة القانونية للمحررات الإلكترونية، باعتبارها وجدت نتيجة لما فرضه الوجود الرقمي لتكنولوجيا المعلومات في ظل مجتمع رقمي يعتمد على استخدام وسائل الاتصال عن بعد، والتي حلت بديلا عن الأساليب التقليدية التي أصبحت لا تتناسب مع طبيعة المعاملات الإلكترونية.
وكما هو معلوم، فالمحررات بالمعنى المفهوم وفقا للنصوص التقليدية هو اعتمادها على الدعامات الورقية المادية، فإذا تمسكنا بها في هذا المعنى، فإن ذلك يعني توقف معظم أو كل الأنشطة التجارية التي تتم عبر شبكة الانترنيت، ويعد هذا بمثابة ضرب في عصب الاقتصاد الوطني وتهديده بالانهيار، لذا كان من الضروري العمل على إيجاد بدائل إلكترونية، تؤدي نفس الأهداف والوظائف التي تؤديها الوسائل التقليدية وبشكل أسرع وأقل تكلفة تأثيثا لمجمع رقمي في المجالات.
وفي ختام هذه الدراسة خلصنا إلى نتائج وتوصيات سوف نوردها وفق الشكل التالي، أملا في تزكية ما سبق التطرق إليه:
*النتائج:
_ لقد سوت التشريعات الدولية والوطنية بين المحررات الإلكترونية والمحررات الكتابية للتساوي الوظيفي بينهما، لذا فإن معظم الدول التي عدلت تشريعها- ومن بينها المغرب- قد وضعت من الشروط ما يسمح بتأمين قيام المحرر الإلكتروني بوظيفة المحرر الخطي في الإثبات، وهذه الشروط بصفة عامة هي قابلية المحرر الإلكتروني للقراءة والمحافظة على سلامة البيانات المدونة به وعدم إمكان تعديلها.
– لكي يحقق المحرر الإلكتروني وظيفته في إثبات التصرف القانوني، فإنه لابد من توفير أعلى مستوى من الأمن والخصوصية في الوسيلة المستخدمة في إنشائه من خلال وسائل تكنولوجية، أهمّها التشفير الذي يحافظ على منظومة التوقيع الإلكتروني ورسالة البيانات المرسلة من عدم دخول أي عبث عليها بتحريفها أو تعديلها، والذي يكون قابلا للكشف في حال حدوثه، كما يمكن من تحديد هوية الشخص مرسلها والتأكد من مصداقيته.
_ دور التوقيع الالكتروني المؤمن في خلق بيئة آمنة للمعاملات الالكترونية، وبالتالي تحقيق الأمن القانوني لها.
_ يمكن للصور المختلفة للتوقيع الإلكتروني من توقيع رقمي وبيومتري والتوقيع الكودي وغيرها من الصور الذي افرزها التعامل الإلكتروني، أن تقوم بتأدية الوظائف التي يقوم بها التوقيع التقليدي من حيث دلالتها على هوية الملتزم بالمحرر وشخصيته وانصراف وإسناد إرادته إلى الالتزام بما وقع عليه.
*التوصيات:
_ ضرورة وضع قواعد وآليات خاصة ومعايير لحفظ المحررات الإلكترونية، وذلك بإنشاء مرافق تعمل على القيام بهذه المهمة، على أن تنظم هذه القواعد والآليات مسؤولية هذه المرافق عن الإخلال بسرية هذه المحررات.
_ العمل على تكوين وإنشاء قضاء متخصص في المجال المعلوماتي كما هو الحال في الدول المتقدمة، حماية لحقوق الأفراد وتطبيقا لديمقراطية النص القانوني.
_ تفعيل أساليب الحماية التي تستخدم من خلال شبكة الإنترنت واسباغ الصفة القانونية بشكل مباشر على التشفير والتوقيع الإلكتروني كأسلوب من أساليب الحماية، وذلك من خلال وضع قواعد قانونية خاصة تجرم الاعتداء على هذه الوسائل.
_ ضرورة تعديل نصوص القانون (53.05) المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية بشكل يضمن الأمن القانوني، وذلك بإعادة صياغتها بشكل سليم ومحكم يساهم في ترسيخ الأمن القانوني.
_ نطالب من المشرع المغربي بضرورة الاتجاه نحو إصدار مدونة رقمية شاملة جامعة للمعاملات والتجارة الإلكترونية.
_ نقترح على الجامعات المغربية – سيرا على ما اهتدت إليه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول بالسطات وبالضبط ماستر المعاملات الإلكترونية – أن تولي موضوع المعاملات الالكترونية والأمن القانوني للتجارة الإلكترونية عناية خاصة، وذلك بإضافة موضوعات ووحدات مخصصة لدراسة قانون الإنترنت وقانون التجارة الالكترونية.
[1] _ القانون رقم 08.09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1/09/15، الصادر في 18 فبراير 2009، منشور بالجريدة الرسمية رقم 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009.
_ القانون رقم 31.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1/11/03، الصادر في 18 فبراير 2011، بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة:1072
_ القانون رقم 53.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1/07/129، الصادر في 30 نوفمبر 2007، بتنفيذ القانون رقم 05.53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية. الجريدة الرسمية عدد 558 بتاريخ 6 ديسمبر 2007، الصفحة:3879.
[2] الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي:
1 – الأهلية للالتزام؛
2 – تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام؛
3 – شيء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام؛
4 -سبب مشروع للالتزام.
وردت في النص الفرنسي عبارة ” les éléments” “العناصر” بدل الأركان كما جاء في الترجمة العربية؛ فالعناصر تستغرق الأركان وشروط الصحة، أما الأركان فهي أجزاء الماهية التي تختل باختلال بعضها. والملاحظ أن الأهلية من حيث المبدأ ليست ركنا، لأنها لا تعتبر من أجزاء الماهية وإنما من شروط الصحة.
وبذلك يمكن صياغة الفقرة 1 من الفصل 2 أعلاه كالآتي: العناصر اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي: …….
[3] سمير حامد عبد العزيز الجمال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة” دراسة مقارنة”، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، الصفحة 105.
[4] محمد حسين منصور، العقود الدولية الالكترونية، المسؤولية الإلكترونية-دار الجامعة الجديدة-الإسكندرية- الصفحة:56.
[5] الياس ناصف، العقود الدولية، “العقد الالكتروني في القانون المقارن” منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، الصفحة: 84
.[6] قرار محكمة النقض عدد 1687 بتاريخ 26 دجنبر 2013 في ملف اجتماعي عدد 2012 / 2 / 5 / 1628 * القاعدة ” عقد الشغل -إبرامه عن الطريق الالكتروني. التعبير عن الإيجاب من خلال شبكة عالمية للاتصالات عن بعد وقبول التعبير عنه بوسيلة الكترونية له أثر يلزم طرفي العقد، فمطالبة الأجير بالعمولة المحددة بالعقد الالكتروني دليل على قبوله مادام العقد الالكتروني لا يعدو أن يكون عقدا عاديا لا يختلف عنه إلا في الطريقة التي انعقد بها عبر وسائل الاتصال الحديثة ”
[7] كشبكة الأنترنيت التي تتيح لنا استخدام البريد الالكتروني أو المواقع الالكترونية أو المواقع التجارية أو غرف المحادثة أو غير ذلك من وسائل التعبير عن الإرادة
[8] تعرف المادة الثانية من قانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم (85) سنة 2001 “الوسيط الالكتروني” بقولها: “برنامج الحاسوب أو أي وسيلة الكترونية أخرى تستعمل من أجل تنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بقصد انشاء رسالة معلومات أو ارسالها أو تسلمها دون تدخل شخصي”
[9] وفق الفقرة الثانية من المادة 65-4 التي تنص على: “دون الإخلال بشروط الصحة المنصوص عليها في العرض، فإن صاحب العرض يظل ملزما به سواء طيلة المدة المحددة في العرض المذكور أو، إن تعذر ذلك، طالما ظل ولوج العرض متيسرا بطريقة إلكترونية نتيجة فعله “.
[10] حليمة بن حفو، التراضي في العقد الإلكتروني، مجلة الأملاك العدد السادس، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، السنة 2009، الصفحة:152.
[11] الفصل 3- 65:” يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية لوضع عروض تعاقدية أو معلومات متعلقة بسلع أو خدمات رهن إشارة العموم من أجل إبرام عقد من العقود.
يمكن توجيه المعلومات المطلوبة من أجل إبرام عقد أو المعلومات الموجهة أثناء تنفيذه عن طريق البريد الإلكتروني إذا وافق المرسل إليه صراحة على استخدام الوسيلة المذكورة.
يمكن توجيه المعلومات إلى المهنيين عن طريق البريد الإلكتروني ابتداء من الوقت الذي يدلون فيه بعنوانهم الإلكتروني.
إذا كان من الواجب إدراج المعلومات في استمارة، تعين وضع هذه الأخيرة بطريقة إلكترونية رهن إشارة الشخص الواجبة عليه تعبئتها”.
[12] العربي جنان، التعاقد الالكتروني في القانون المغربي (دراسة مقارنة)، المطبعة والوراقة الوطنية الداوديات، مراكش، سلسلة التنظيم القانوني للمعلوميات والانترنيت، الطبعة الأولى، السنة 2010، الصفحة:99.
[13] يتضمن العرض، علاوة على ذلك، بيان ما يلي:”
1 – الخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة المقترحة أو الأصل التجاري المعني أو أحد عناصره ؛
2 – شروط بيع السلعة أو الخدمة أو شروط تفويت الأصل التجاري أو أحد عناصره ؛
3 – مختلف المراحل الواجب اتباعها لإبرام العقد بطريقة إلكترونية ولا سيما الكيفية التي يفي طبقها الأطراف بالتزاماتهم المتبادلة ؛
4 – الوسائل التقنية التي تمكن المستعمل المحتمل، قبل إبرام العقد، من كشف الأخطاء المرتكبة أثناء تحصيل المعطيات وتصحيحها ؛
5 – اللغات المقترحة من أجل إبرام العقد ؛
6 – طريقة حفظ العقد في الأرشيف من لدن صاحب العرض وشروط الاطلاع على العقد المحفوظ إذا كان من شأن طبيعة العقد أو الغرض منه تبرير ذلك ؛
7 – وسائل الاطلاع، بطريقة إلكترونية، على القواعد المهنية والتجارية التي يعتزم صاحب العرض الخضوع لها، عند الاقتضاء.
كل اقتراح غير متضمن لكافة البيانات المشار إليها في هذا الفصل لا يجوز اعتباره عرضا بل يبقى مجرد إشهار، ولا يلزم صاحبه”.
ومقتضيات هذه الفقرة فإنها تتقاطع مع مقتضيات المادة 29 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك والتي تنص على أنه: “دون الإخلال بالمعلومات المنصوص عليها في المادتين 3 و5 أو في أي نص تشريعي أو تنظيمي آخر جاري به العمل، يجب أن يتضمن العرض المتعلق بعقد البيع عن بعد المعلومات التالية:
1- التعريف بالمميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل العرض ؛ =
2- = اسم المورد وتسميته التجارية والمعطيات الهاتفية الت- إذا كان منتميا لمهنة منظمة، فمرجع القواعد المهنية المطبقة وصفته المهنية والبلد الذي حصل فيه على هذه الصفة وكذا اسم الهيئة أو التنظيم المهني المسجل فيه.
ي تمكن من التواصل الفعلي معه وبريده الالكتروني وعنوانه وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي فمقره الاجتماعي، وإذا تعلق الأمر بغير المورد فعنوان المؤسسة المسؤولة عن العرض؛
بالنسبة للتاجر السيبراني :
– إذا كان خاضعا لشكليات القيد في السجل التجاري، فرقم تسجيله ورأسمال الشركة؛
– إذا كان خاضعا للضريبة على القيمة المضافة، فرقم تعريفه الضريبي؛
– وإذا كان نشاطه خاضعا لنظام الترخيص، فرقم الرخصة وتاريخها والسلطة التي سلمتها ؛
3- أجل التسليم ومصاريفه إن اقتضى الحال ؛
4- وجود حق التراجع المنصوص عليه في المادة 36، ما عدا في الحالات التي تستثنى فيها أحكام هذا الباب ممارسة الحق المذكور؛
5- كيفيات الأداء أو التسليم أو التنفيذ ؛
6- مدة صلاحية العرض وثمنه أو تعريفته ؛
7- تكلفة استعمال تقنية الاتصال عن بعد ؛
8- المدة الدنيا للعقد المقترح، إن اقتضى الحال، عندما يتعلق الأمر بتزويد مستمر أو دوري لمنتوج أو سلعة أو خدمة =
= تبلغ المعلومات المذكورة، التي يجب أن يتجلى طابعها التجاري دون التباس، إلى المستهلك بصورة واضحة ومفهومة عن طريق كل وسيلة ملائمة للتقنية المستخدمة للاتصال عن بعد.
دون الإخلال بمقتضيات القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، يجب على المورد أن يذكر المستهلك قبل إبرام العقد بمختلف اختياراته، وأن يمكنه من تأكيد طلبيته أو تعديلها حسب إرادته.
[14] Loi N94-665 du 4 aout 1994 relative a l’emploi de la langue française, plus connue sous le nom de loi « Toubon » .
[15] Article 2 : « Dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire.
Les mêmes dispositions s’appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle.
[16] Article 2.1.3 Circulaire du 19 mars 1996 concernant l’application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française « Les dispositions ci-dessus sont applicables lors de la commercialisation en France des biens, produits ou services quelle que soit l’ origine de ceux-ci. Il s’agit en effet d’assurer la protection du consommateur afin qu’il puisse acheter et utiliser un produit ou bénéficier de services en ayant une parfaite connaissance de leur nature, de leur utilisation et de leurs conditions de garantie ».
[17] والتي تنص على أنه:” يجب أن تحر البيانات وطريقة الاستخدام ودليل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص عليها في التنظيم الساري المفعول باللغة العربية أساسان وعلى الإضافة، يمكن استعمال لغة أو عدة لغات سهلة الفهم من المستهلكين وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوها”.
[18] المادة 206 من القانون رقم 31.08 سالف الذكر والتي نصت على أنه: “إن كل عقد حرر بلغة أجنبية يصطحب وجوبا بترجمة إلى العربية”.
على اعتبار أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة وفق ما جاءت به الفقرة الأولى من المادة الخامسة من دستور الملكة المغربية لسنة 2011.
[19] الفقرة الثانية من الفصل 65-4 ظهير العقود والالتزامات.
[20] ماء العينين سعداني، الأمن القانوني للتجارة الالكترونية-دراسة مقارنة-أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال، جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بسطات، السنة الجامعية :2016 -2017.
[21] العيشي عبد الرحمان، ركن الرضا في العقد الالكتروني، أطروحة دكتوراه في العلوم-تخصص قانون- قسم القانون الخاص، جامعة الجزائر 1 كلية الحقوق، السنة الدراسية: 2016- 2017.
[22] محمد الشرقاني، القانون المدني، العقد، الإرادة المنفردة، المسؤولية التقصيرية، المرجع السابق، الصفحة: 68.
[23] إيمان التيس، التجارة الإلكترونية وضوابط حماية المستهلك في المغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق قانون خاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة مولاي إسماعيل، السنة الجامعية: 2014. الصفحة: 220.
[24] “يشترط لصحة إبرام العقد أن يكون من أرسل العرض إليه قد تمكن من التحقق من تفاصيل الإذن الصادر عنه ومن سعره الإجمالي ومن تصحيح الأخطاء المحتملة، وذلك قبل تأكيد الإذن المذكور لأجل التعبير عن قبوله.
يجب على صاحب العرض الإشعار بطريقة إلكترونية، ودون تأخير غير مبرر، وبطريقة إلكترونية، بتسلمه قبول العرض الموجه إليه.
يصبح المرسل إليه فور تسلم العرض ملزما به بشكل لا رجعة فيه.
يعتبر قبول العرض وتأكيده والإشعار بالتسلم متوصلا بها إذا كان بإمكان الأطراف المرسلة إليهم الولوج إليها”.
[25] ماء العينين سعداني،الأمن القانوني للتجارة الالكترونية –دراسة مقارنة- المرجع السابق، الصفحة:114.
[26] هذا الأمر يتقاطع مع مقتضيات القانون 31.08 السابق الذكر، فقد جاء في المادة 29 منه وذلك في الفقرة الأخيرة ما يلي: ” دون الإخلال بمقتضيات القانون رقم 53. 05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، يجب على المورد ان يذكر المستهلك قبل إبرام العقد بمختلف اختياراته، وأن يمكنه من تأكيد طلبيته أو تعديلها حسب إرادته”.
[27] المختار بن أحمد العطار، العقد الالكتروني، مطبعة النجاح الجديدة –الدار البيضاء -الطبعة الأولى 2010، الصفحة:32
[28] العربي جنان، التعاقد الالكتروني في القانون المغربي – دراسة مقارنة – المرجع السابق، الصفحة:103.
[29] لكن بالرجع الى مقتضيات الفصل 65-1 ظهير الالتزامات والعقود، نجد أن المشرع المغربي استثنى من الأحكام المطبقة على العقد الموجه بطريقة الكترونية الفصول من 23 الى 30 والفصل 32، مما يستفاد معه ا المشرع المغربي لا يعد- وان كان ضمنيا- بالسكوت كدلالة على القبول في العقود المبرمة بشكل الكتروني.
[30] نسرين محاسنه – انعقاد العقد الالكتروني ( دراسة مقارنة بين قانون المعاملات الالكترونية الأردني لسنة 2001 م والقانون النموذجي للتجارة الالكترونية لسنة 1996 م ) دراسات علوم الشريعة والقانون – المجلد 31 – العدد الثاني – سنة 2004 م – الصفحة: 327
[31] اسامة أحمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2002، الصفحة : 205 – 207.
[32] عبدالله محمود حجازي، العقود الالكترونية التراضي، التعبير عن الإرادة –دراسة فقهية مقارنة- الطبعة الأولى، دار الحامد، عمان، طبعة سنة:2007، الصفحة :47.
[33] عبد الكريم عباد، حماية المستهلك في عقد التجارة الالكترونية، مجلة الدفاع، مجلة تصدرها هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بسطات، العدد السادس، سنة 2011، الصفحة:106.
[34] ونظرا لاهتمام المشرع بأحكام التعاقد عن بعد، جعل من أحكامه من النظام العام وفقا لمقتضيات المادة: 44 من قانون 31.08.
[35] التي تنص على أنه للمستهلك أجل:”
_ سبعة أيام كاملة لممارسة حقه في التراجع،
_ ثلاثين يوماً لممارسة حقه في التراجع في حالة ما لم يفي المورد بالتزاماته بالتأكيد الكتابي للمعلومات المنصوص عليها في المادتين 29 و 32،
_ وذلك دون حاجة إلى تبرير ذلك أو دفع غرامة باستثناء مصاريف الإرجاع إن اقتضى الحال ذلك تسري الآجال المشار إليها في الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ تسلم السلعة أو قبول العرض فيما يتعلق بتقديم الخدمات “.
[36] حيث نصت على أنه: “لا يمكن أن يمارس حق التراجع إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك في العقود المتعلقة بما يلي:
-1 التي شرع في تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء أجل السبعة أيام كاملة،
– 2 التزويد بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يكون ثمنها أو تعريفها رهينا بتقلبات أسعار السوق كاملة،
-3 التزويد بالسلع المصنوعة حسب مواصفات المستهلك أو المعدة له خصيصا أو التي لا يمكن بحكم طبيعتها إعادة إرسالها أو تكون معرضة للفساد أو سرعة التلف.
– 4 التزويد بتسجيلات سمعية أو بصرية أو برامج معلوماتية عندما يطلع عليها المستهلك،
– 5 التزويد بالجرائد أو الدريات أو المجلات”.
[37] عبد الكريم عباد، حماية المستهلك الالكتروني في عقد التجارة الالكترونية، المرجع السابق، الصفحة:107.
[38] أستاذنا الدكتور نورالدين الناصري، المعاملات والاثبات في مجال الاتصالات الحديثة، سلسة الدراسات القانونية المعاصرة 12، الطبعة الأولى،2007،الصفحة:2.
[39] أستاذنا الدكتور نورالدين الناصري، حجية الدليل الرقمي في ضوء القانون 05.53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، مقال منشور بمجلة الدفاع الصادرة عن هيأة المحامين بسطات، تحت عدد خاص: “المنازعات والمعاملات ذات الطابع الالكتروني” العدد 13، سنة: 2019، الصفحة:9.
[40] وهو ما اكدت عليه محكمة النقض في قرار عدد 5817 بتاريخ 2012 / 12 / 25 ملف مدني عدد 2012 / 7 / 1 / 285 “الوثيقة المحررة على دعامة الكترونية – دليل صحيح – نفس قوة الإثبات للمحرر الورقي ( نعم )”.
[41] أستاذنا نورالدين الناصري، المعاملات والإثبات في مجال الاتصالات الحديثة، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، العدد 12، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2007، الصفحة: 9.
[42] أضافها القانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 يونيو 2000، في المجلة التونسية للالتزامات والعقود.
[43] طارق البختي، مدى حجية المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في الإثبات، المجلة المغربية لقانون الأعمال المقاولات، العدد 14 – 15، السنة 2008.الصفحة: 91.
” [44]تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق.
تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات، شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على الورق، شريطة أن يكون بالإمكان التعرف، بصفة قانونية، على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها “.
[45] اسية الحراق، الاثبات بالوسائل الالكترونية، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، فترة التدريب 2015-2017، الصفحة:22.
[46] جواد الرجواني، المركز القانوني لمقدمي خدمة المصادقة الإلكترونية، المرجع السابق، الصفحة:39.
[47] قرار محكمة النقض قرار عدد 1687 بتاريخ 26 دجنبر 2013 في ملف اجتماعي عدد 2012 / 2 / 5 / 1628 * القاعدة ” عقد الشغل -إبرامه عن الطريق الالكتروني. التعبير عن الإيجاب من خلال شبكة عالمية للاتصالات عن بعد وقبول التعبير عنه بوسيلة الكترونية له أثر يلزم طرفي العقد، فمطالبة الأجير بالعمولة المحددة بالعقد الالكتروني دليل على قبوله مادام العقد الالكتروني لا يعدو أن يكون عقدا عاديا لا يختلف عنه إلا في الطريقة التي انعقد بها عبر وسائل الاتصال الحديثة “.
[48] قرار محكمة النقض قرار عدد 5817 بتاريخ 2012 / 12 / 25 ملف مدني عدد 2012 / 7 / 1 / 285 الوثيقة المحررة على دعامة الكترونية – دليل صحيح – نفس قوة الإثبات للمحرر الورقي ( نعم ).
[49] قرار صادر عن محكمة النقض عدد1/250 الصادر بتاريخ 2013 / 06 / 06 في الملف التجاري عدد : 2012 / 1 / 3 / 894 القاعدة المشرع المغربي أضفى على الوثائق الإلكترونية الحجية في الإثبات بمقتضى الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 05 . 53 المؤرخ في 2007 / 11 / 30 المتعلق بالتبادل الالكتروني تتميما للفصل 417 من ق . ع . ل حيث اعتبرها دليلا كتابيا بعد أن عرف الدليل الكتابي بأنه الدليل الناتج عن الوثائق المحررة على الورق أو الوثائق الخاصة أو عن أية إشارة أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها.
[50] وهو ما ذهبت اليه محكمة النقض في القرار عدد : 1 / 513 المؤرخ في : 15 / 12 / 2016 قلق تجاري عدد : 2014 / 1 / 3 / 1340 المحررات الإلكترونية لا تكتسب الحجية الكاملة إلا إذا كنت موقعة توقيعا إلكترونيا مؤمنا بموجب المادة السادسة من القانون 05 – 53 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية التي تنص على أن : ” يجب أن يستوفي التوقيع الإلكتروني المؤمن ( . . . ) الشروط التالية – أن يكون خاص بالموقع – أن يتم إنشاؤه بوسائل يمكن للموقع الأحفاد بها تحت مراقبته الخاصة بشقة حصرية : أن يضمن وجود ارتاح بالوثيقة المتحصنة به بكيفية تؤدي كشف أي تغيير حق أدخل عليها ”
[51] محمد أوزيان، مدى إمكانية استيعاب نصوص الاثبات في ظهير الالتزامات والعقود للتوقيع الالكتروني، مقال منشور في مجلة القضاء والقانون، العدد 155، سنة 2008، الصفحة: 37.
[52] عزيز جواهري، التوقيع الالكتروني والاثبات، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، شعبة القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. الرباط، أكدال، السنة الجامعية 2004 – 2005، الصفحة:7.
[53] أحمد البختي، استعمال الوسائل الالكترونية في المعاملات التجارية. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، السنة الجامعية: 2003 – 2004، الصفحة:41.
[54] عبد الفتاح حجازي، التوقيع الالكتروني في النظم المقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، السنة:2005، الصفحة:14.
[56] قرار عن محكمة النقض يحدد الفرق بين التوقيع التقليدي والتوقيع الالكتروني عدد 250 الصادر بتاريخ 2013/06/06 في الملف رقم 2012/1/3/894:
القاعدة:
“لئن كان التوقيع هو المجسد لإرادة الملتزم ويتم في الحالات العادية بوضع علامة بخط يد الملتزم نفسه طبقا لأحكام الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود , فإن التوقيع الالكتروني لا يكون بنفس طريقة التوقيع التقليدي, بل إنه وبمقتضى الفصل 417 من نفس القانون يكون بكل ما يتيح التعرف على الشخص الموقع ويعبر عن قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثيقة الالكترونية, ومن ثم لا يشترط توقيع هذه الوثيقة بيد الملتزم, ولا وضع خاتمه عليها.
مادامت المحكمة استندت فيما انتهت اليه الى إقرار الطالبة الوارد بالرسائل الصادرة عنها المحددة لمبالغ العمولة المستحقة للمطلوبة, فإنها لم تكن في حاجة للبحث في تكييف العقد الرابط بين الطرفين”.
[57] محكمة النقض القرار عدد : 1 / 513 المؤرخ في : 15 / 12 / 2016 قلق تجاري عدد : 2014 / 1 / 3 / 1340 المحررات الإلكترونية لا تكتسب الحجية الكاملة إلا إذا كنت موقعة توقيعا إلكترونيا مؤمنا بموجب المادة السادسة من القانون 05 – 53 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية التي تنص على أن : ” يجب أن يستوفي التوقيع الإلكتروني المؤمن ( . . . ) الشروط التالية – أن يكون خاص بالموقع – أن يتم إنشاؤه بوسائل يمكن للموقع الأحفاد بها تحت مراقبته الخاصة بشقة حصرية : أن يضمن وجود ارتاح بالوثيقة المتحصنة به يكيقية تؤدي كشف أي تغيير حق أدخل عليها “.
[58] تطرقت المادة 7 من القانون (53.05) الى تعريف الموقع المشار إليه في المادة 6 أعلاه بكونه هو:” الشخص الطبيعي الذي يعمل لحسابه الخاص او حساب الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمثله والذي يستخدم آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني”. فيما عرفه قانون التجارة الإلكترونية لإمارة دبي لعام 2002 في المادة 21 صاحب التوقيع الالكتروني أو الموقع بأنه:” الشخص السمعي أو المعنوي الحائز لأداة توقيع الكتروني خاصة به، ويقوم بالتوقيع او يتم التوقيع نيابة عنه على الرسالة الالكترونية باستخدام هذه الأداة”.
[59] التي تقابلها المادة 21 من قانون التجارة الالكترونية لإمارة دبي لعام 2002التي تعرف أداة التوقيع بكونها:” جهاز أو معلومات الكترونية معدة بشكل فريد لتعمل بشكل مستقل أو بالاشتراك مع أجهزة ومعلومات إلكترونية أخرى على وضع توقيع الكتروني لشخص معين، وتشمل هذه العملية أية أنظمة أو أجهزة تنتج أو تلتقط معلومات فريدة مثل رموز أو مناهج”.
[60] العربي حنان، التعاقد الالكتروني في القانون المغربي، المرجع السابق، الصفحة: 115.
[61] طارق كميل، التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس أكدال، الرباط، السنة الجامعية 2007 – 2008، الصفحة: 20.
[62] ماء العينين سعداني، الأمن القانوني للتجارة الالكترونية- دراسة مقارنة-، المرجع السابق، الصفحة:161.
[63] أستاذنا ضياء أحمد علي نعمان، المصادقة الالكترونية على ضوء القانون رقم (53.05) المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، العدد الأول، أكتوبر، سنة:2009، الصفحة:152.
[64] اسية الحراق، الاثبات بالوسائل المعلوماتية، المرجع السابق، الصفحة: 43.
[65] Alain Rallet, « commerce électronique ou électrisation du commerce ? » Réseaux 201/2 (no 106), Doi 10.3917/res.106,0017.Page:70.
[66] مولاي حفيظ علوي قادري، إشكالات التعاقد في التجارة الالكترونية، نشر وتوزيع الشركة المغربية لتويع الكتاب، الطبعة الأولى: 2013، الصفحة: 82.
[67] أستاذنا نورالدين الناصري، حجية الدليل الرقمي في ضوء القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، المرجع السابق، الصفحة: 36.
وللاطلاع أكثر يمكن الرجوع إلى:
– Bouden Halima, La fiabilité de la signature électronique, revue du droit marocain, n°17, avril 2011.
المعلومة القانونية
*عبد الإله معداد
طالب باحث في سلك ماستر المعاملات الالكترونية