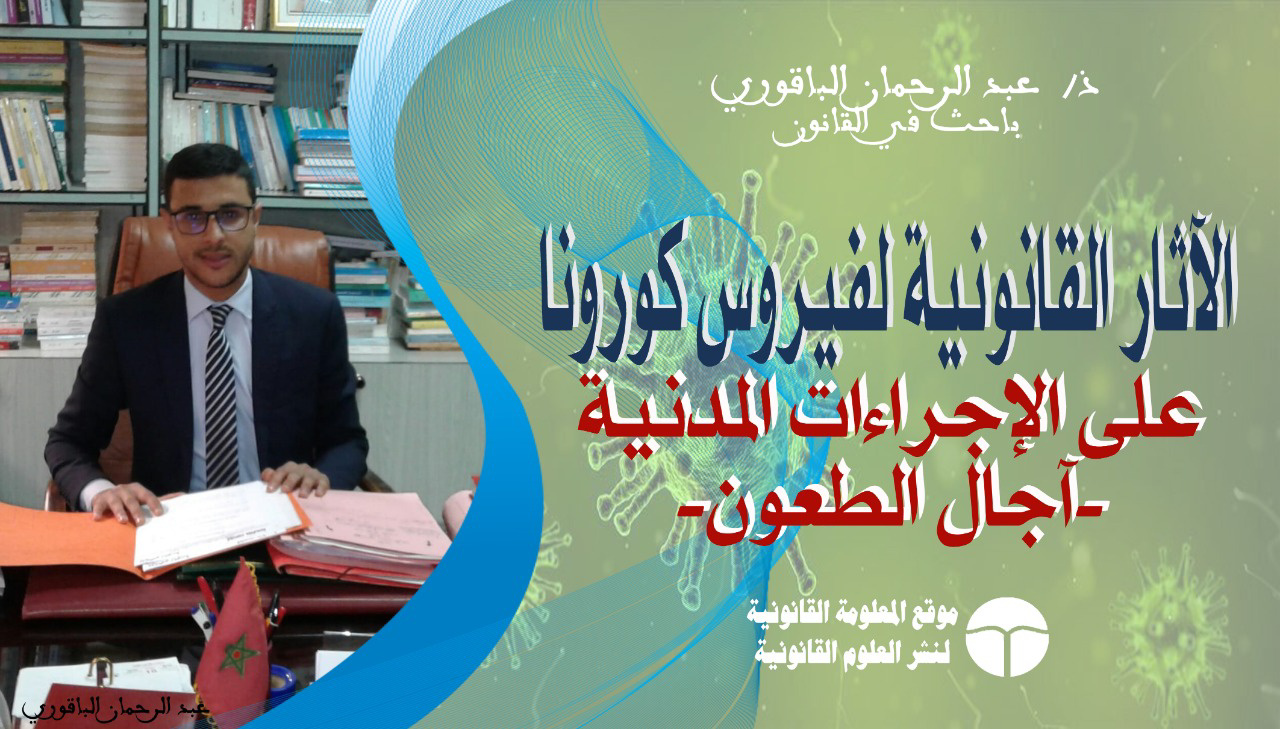ذ. الباقوري: الآثار القانونية لفيروس كورونا على آجال الطعون المدنية
المعلومة القانونية – عبد الرحمان الباقوري
- باحث في القانون
تمهيد
أصبح موضوع فيروس كورونا كوفيد-19 المستجد، شأنا دوليا، ومحل تتبع واستطلاع شديدين، اقليميا ووطنيا، بل لا تكاد تجد منزلا إلا وهو حديثهم، بسبب تهديده المتزايد لكافة الميادين والمجالات،الصحية والاقتصادية والسياحية، وحتى القانونية، وعلى ذلك، أضحى من الضروري بسط النظر على بعض تأثيراته على الجوانب القانونية خاصة الاجرائية منها، متوخين في ذلك المسؤولية والموضوعية والتجرد.
واستنادا إلى مقولة إن الحقوق تحمى بالإجراءات لا بالموضوع، كان لزاما الالتفات إلى ما لهذا الوباء العالمي من آثار قانونية على الإجراءات المدنية، خاصة منها ما يرتبط بآجال الطعون، لارتباطها الوثيق من جهة أولى، بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، ومن جهة ثانية، على ما يرتبه انصرام مددها من وقع بليغ على تلك الحقوق.
وعلى ذلك، سنحاول من خلال هذه المقالة، تسليط الضوء على الآثار القانونية لفيروس كورونا على الإجراءات المدنية، مكتفيا بالإجراءات المتعلقة بآجال الطعون. وذلك من خلال محورين، أخصص الأول لتحديد مفهوم آجال الطعون وطبيعتها، قبل أن انتقل في محور ثاني لتحديد هذه الآثار ذات الوقع البليغ.
المحور الأول: آجال الطعون؛ تحديد الطبيعة والآثار
أجل الإجراء هو الفترة الزمنية التي حددها القانون للقيام بإجراء ما، وأوجب القيام به خلال هذه المدة أو بعد نهايتها أو قبل بدايتها تحت طائلة سقوط الحق في الاجراء[1].
وآجال الطعون[2]، هي المواعيد التي بانقضائها يسقط الحق في الطعن في المقررات القضائية، تطبيقا للفصل 511 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على : ” تحترم جميع الآجال المحددة بمقتضى هذا القانون لممارسة أحد الحقوق وإلا سقط الحق“. وقد قضى المجلس الأعلى – محكمة النقض – في أحد قراراته :” إن الحكم الابتدائي يكتسب بانصرام أجل الاستئناف قوة الشيء المحكوم به ويصبح الاستئناف غير مقبول بعدئذ لسقوط الحق فيه تطبيقا للفصل 511 من قانون م م “[3].
إن الفصل 511 من قانون المسطرة المدنية سالف الذكر، يضع قاعدة عامة من مقتضاها : أنه إذا خول القانون للشخص حقا إجرائيا معينا، وأوجب عليه أن يباشر العمل الذي يستند إلى هذا الحق خلال ميعاد محدد، أو في ترتيب معين بالنسبة لأعمال أو وقائع الخصومة الأخرى[4]، ولم يلتزم الخصم أو المتقاضي عموما بهذا القيد الزمني، لم يعد من حقه القيام بهذا العمل، ويسقط بالتبعية حقه فيه[5].
وآجال الطعون لها مساس بالنظام العام[6]، وترتيبا على ذلك يمكن للخصوم التمسك بعدم مراعاتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون لزاما على محاكم الموضوع وعلى محكمة النقض مراقبة احترامها، ولا يمكن للقاضي أن يعفي المعني بالأمر من الأجل، ولو بموافقة الخصم، وكل ما يمكن أن يحصل هو تطبيق نص قانوني يقضي بتمديد أو توقيف هذه الآجال، كما هو الحال بالنسبة للتمديد في الفصل 136 من ق م م، وبالنسبة للوقف في الفصول 137 و 139 و 358 و 403 من قانون المسطرة المدنية، التي تتعلق على التوالي بتوقف أجل الاستئناف بسبب وفاة أحد الأطراف، وتوقفه كذلك بسبب تغير أهلية أحدهم، فيما يتوقف أجل الطعن بالنقض بمناسبة إيداع طلب المساعدة القضائية بكتابة ضبط محكمة النقض، وتوقف أجل التماس إعادة النظر طبقا للفصل 403 المحيل على الفصلين 137 و 139 من نفس القانون.
و آجال الطعون، باعتبارها آجال سقوط[7]، فإنها، باستثناء ما ذكر أعلاه، كقاعدة لا تخضع للتوقف، ولا تخضع للانقطاع مطلقا، عكس التقادم، الذي تتوقف مدته وتنقطع[8].
إلى هنا نكون قد حددنا مفهوم أجال الطعون، وبينا طبيعتها، فهل يكتسي فيروس كورونا المستجد طبيعة القوة القاهرة ؟ وما الآثار القانونية التي قد يرتبها هذا الفيروس على آجال الطعون ؟
المحور الثاني: علاقة فيروس كورونا بالقوة القاهرة وتأثيره على آجال الطعون
أولا: فيروس كورونا والقوة القاهرة؛ أي علاقة
في تحديد هذه العلاقة، سيكون لزاما علينا بيان ما إذا كان بالامكان وصف هذا الفيروس بالقوة القاهرة، منطلقين من جهة أولى، بتحديد مفهوم القوة القاهرة وما إذا كانت تنطبق عليه شروطها، ومن جهة ثانية، من اعتبار منظمة الصحة العالمية لهذا الفيروس بالجائحة والوباء العالمي.
فالقوة القاهرة، هي :”كل واقعة تنشأ باستقلال عن إرادة المدين، ولا يكون باستطاعته توقعها أو منعها، ويترتب عليها أن يستحيل عليه مطلقا الوفاء بالتزامه…”[9]، أو باعتبارها “تتكون من كل واقعة غير متوقعة ومستحيلة الدفع وتتسم بعنصر خارجي”[10]. وفي ذلك يقول بن عاصم[11]:
وكل ما لا يستطاع الدفع لــــــه جائحة مثل الرياح المرســل
والجيش معدودة من الجوائـــــح كفتنة و كالعدو الكاشـــح
أما المشرع المغربي فقد نظم القوة القاهرة في الفرع الثاني من القسم الرابع من ظهير العقود والالتزامات، الذي خصص لآثار الالتزامات بوجه عام، وما يتصل منها بتلك التي تجد مصدرها في العقد مباشرة، أو تلك التي تجد مصدرها في غيره من مصادر الالتزام الأخرى كالمسؤولية التقصيرية أو الإثراء بلا سبب على سبيل المثال. وهكذا فبعدما قرر المشرع المغربي من خلال مقتضيات الفصل 268 من هذا الظهير، “أنه لا محل لأي تعويض مدني كلما استطاع المدين أن يثبت أن عدم تنفيذه الالتزام الذي يثقل كاهله أو التأخير في ذلك التنفيذ، قد نشأ بالأساس عن سبب أجنبي لا يمكن أن يعزى إليه كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو مطل الدائن“،فإنه حاول وضع تعريف للقوة القاهرة من خلال مقتضيات الفصل 269 منه، إذ نص إن :”القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية (الفيضانات، الجفاف، الحرائق، الجراد) وغارات العدو، وفعل الأمير، ويكون من شانه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا. ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه، ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين“.
وعليه، يظهر لنا شروط القوة القاهرة، والتي هي :
1 – انعدام التوقع؛
2 – انعدام الدفع؛
3 – انتفاء خطأ المتمسك بها.
بعد هذا التأطير، يمكن التساؤل عما إذا كان مسموحا إسقاط وصف القوة القاهرة على فيروس كورونا المستجد واعتباره تطبيقا من تطبيقاتها !
من الناحية المبدئية يمكن القول، إن ما يلزم توافره في القوة القاهرة حتى تعتبر بهذه الصفة في التشريع المغربي، متوافر في هذا الفيروس العالمي، فهو من جهة ظهر بشكل فجائي ولم يكن لدى أي واحد في العالم إمكانية توقعه، ومن جهة ثانية ونظرا لتفشيه الواسع في العالم، فقد تحقق شرط استحالة دفعه، نظرا لما خلفه من آلاف الوفيات وعديد الآلاف من المرضى، ومن جهة أخيرة فإن الشرط الثالث المتمثل في انتفاء خطأ المدين فيضحى عنصرا غير مطلوب منطقيا في هذه الحالة.
ثانيا: تأثير فيروس كورونا على آجال الطعون
أعلنت مؤخرا العديد من الدول كلبنان وفلسطين والستغال وتونس و السودان واليوم مصر وفرنسا، جملة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها تقليص العمل بالمحاكم بغية الحد من انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 المستجد، ومن المتوقع ربما أن تتزايد حدة هذه الإجراءات بما يؤدي إلى تعطيل جزئي أو كلي لعمل المحاكم، بل إن بيان وزارة العدل المصرية يوحي بذلك، إذ نص على : “ولما كانت المحاكم بأنواعها تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية، ولذلك نسق معالي المستشار وزير العدل مع كل من السيد القاضي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء والقاضي رئيس مجلس الدولة والمستشار النائب العام والسادة القضاة …..لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم دون حضور أطراف التداعي، وعدم شطب أي دعوى، مع استمرار العمل الاداري بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونا“.
وأمام هذا الوضع، يطرح الكثيرون جملة من التساؤلات والتخوفات حول تأثير هذا الفيروس العالمي، المتصف بوصف الجائحة، على مواعيد الطعون استئنافا ونقضا، سيما وإن هذه المدد كما تقدم مدد إسقاط من متعلقات النظام العام.
الحقيقة، وفي حدود ما وصل إلى علمي، لم أجد أي تطبيق وطني، قضائي أو تشريعي، تصدى للأمر ورتب عن الأوبئة التي مر بها العالم في العشرين سنة السابقة أي أثر، سواء وباء SARS سنة 2003 و H1H1 سنة 2009 و EBOLA سنة 2014، ليتجدد النقاش اليوم بخصوص فيروس كورونا المستجد والذي ألقى بظلاله على أزيد من 123 دولة.
لكن الاجتهادات القضائية العليا في بعض الدول العربية، جرت على ايجاد حلول لهذه المسألة، بأن فتحت الباب للسلطة التقديرية للهيئات القضائية الدنيا، بتقدير الوضع والظرفية، فهذه محكمة النقض المصرية أكدت على : ” وجوب وقف ميعاد الطعن أثناء القوة القاهرة”[12]، وفي قرار آخر لها قضت فيه أن : ” ميعاد الطعن بالاستئناف وفقا للمادة 228 من قانون المرافعات هو 40 يوما ما لم ينص على غير ذلك، ويترتب على عدم احترامه سقوط الحق في ممارسته، إلا أن هذا الميعاد يتوقف سريانه إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ يستحيل على الخصم مباشرة إجراءات الطعن ومواصلة السير فيه”[13]، ثم أكدت نفس المحكمة على أن : ” تعطل عمل المحاكم وعدم تمكن المتقاضين من اتخاذ اجراءات الطعن في مواعيدهان هو من قبيل القوة القاهرة التي توجب توقف ميعاده”[14].
خاتمة
ختاما، وعلى امتداد صفحات هذا البحيث، ومن خلال ما استشهد به من قرارات لمحكمة النقض المصرية، فإن يجب التقرير بما قررته هذه المحكمة، إذ يجب أن ينسحب ما أكدت عليه بضرورة القياس، لاتحاد العلة بين المقيس على المقاس عليه، على الحالة التي يكون فيها انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حائلا دون ممارسة المتقاضين لحقوقهم في الطعن داخل المواعيد المقررة قانونا. وقد شهدنا يوم 16 مارس 2020 اصدار القرار المشترك بين وزارة العدل المغربية والمجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بشأن تعليق عمل مختلف المحاكم في أغلب القضايا، بل إن المؤشرات تنم عن الاتجاه نحو إيقاف جميع أنشطة المحاكم الإدارية، بعد أن علقت أغلب الانشطة القضائية، وبناء على هذا، ألم يحن للمشرع التدخل وإقرار توقف آجال المساطر القانونية القضائية أثناء هذه الوضعية الاستثنائية وبالخصوص آجال الطعون، أو على الأقل تخويل المحاكم في ضوء ما تراه من وقائع وظروف أن تعمد، وتحقيقا للعدالة، إلى دراسة واقع كل قضية على حدة، لتقرر ما إذا كان تعطل عمل المحاكم، بسبب انتشار هذا الفيروس، في منطقة معينة وبتواريخ محددة تحديدا دقيقا، سببا لاعتبار هذا الفيروس وما يترتب على منع انتشاره قوة قاهرة تحول دون تمكين الطاعنين من القيام باجراءات الطعن، والتقرير بوقف سريان الميعاد تبعا لذلك، مع ترتيب آثار الوقف، بأن لا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط، وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حنى يزول سببه، فإذا زال، يستأنف سير الميعاد وتضاف المدة السابقة على الوقف إلى المدة اللاحقة له عند احتساب الطعن.
البيبليوغافيا
[1] – عبد العزيز توفيق، آجال الإجراءات في التشريع المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء 1990، ص 11.
[2] – الأجل لغة هو مدة الشيء، او غاية الوقت المحدد للشيء، وجمعه آجال أو آجالات.
المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، المركز العربي للثقافة والعلوم بيروت ، لبنان، ص 7
واصطلاحا هو الفترة من الزمن يوقتها المتعاقدون او القانون او القاضي لاجل القيام بعمل قانوني أو ارتقاب لحدوث حادث او سقوط حق.
ابراهيم لمحار ومن معه، ” القاموس القانوني”، فرنسي – عربي، مكتبة لبنان، 1983، ص 91.
[3] – قرار المجلس الأعلى 21 بتاريخ 1/2/62 الطيب بن لمقدم، م س. ص 46.
وقضى المجلس الاعلى في قرار آخر : ” إن مجرد تقديم طلب الاستئناف الخالي من البيانات الالزامية المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية والمتعلقة بذكر الوقائع وأسباب الاستئناف يؤدي الى البطلان ولم تكن المحكمة ملزمة بالالتفات للمذكرة المتضمنة لذلك والتي قدمت خارج الاجل القانوني الاستئناف، كما لم تكن ملزمة بان توجه الى المستانف اي انذار بذلك والحال ان اجل الاستئناف قد انقضى“.
قرار المجلس الأعلى ع 2806 بتاريخ 4/12/85، أشار له الطيب بن لمقدم ” الطعون المدنية في التشريع المغربي” مطبعة ديديكو سلا 1966، ج 1، ص 46
[4] – كما هو الحال بالنسبة للدفوع، فإذا اجتمعت عدة منها، توجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص أولا، لأن الاختصاص هو السلطة التي تسمح للمحكمة بالبت الدعوى التي تمارس إما من خلال الطلبات أو الدفوع الشكلية أوالموضوعية أوبعدم القبول، فكان لزاما الدفع به- أي الدفع بعدم الاختصاص- أولا قبل سائر الدفوع الأخرى عملا بالفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، إذ قضت محكمة النقض في أحد قراراتها تحت عدد 2338 في الملف الاجتماعي عدد 900 /5/1/2013، غير منشور : ” إن الدفع بعد الاختصاص جاء لاحقا للدفع بعدم قبول الطلب، والمشرع بمقتضى الفصل 16 الذي لم يميز بين المكاني والنوعي، ألزم أن يكون الدفع بعدم الاختصاص سابقا على أي دفع آخر أو دفاع في الجوهر“. ثم بعده تلي الدفوع الشكلية التي يجب أن تثار قبل كل دفاع في الجوهر اعمالا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية.
[5] – يلاحظ إن السقوط هنا يتحقق بصرف النظر عن القيام بالعمل الاجرائي، فإذا حدد القانون للقيام بالعمل أجلا أو ترتيبا معينا، وانقضى هذا الأجل أو الظرف الزمني المعين دون مباشرة هذا العمل، سقط الحق في القيام به، فإذا قام الخصم بالعمل بعد ذلك تحقق جزاءان :
أولا السقوط : الذي يتحقق قبل القيام بالعمل.
ثانيا البطلان : الذي يطال العمل الاجرائي المباشر في غير الظرف الزمني الذي نص عليه القانون.
والبطلان هنا، يعتبر بطلانا لعيب في الشكل، إذ يعتبر الزمن مقتضى شكليا للعمل الاجرائي.
[6] – إن التقرير بما اذا كان ميعاد ما من مواعيد المرافعات بصفة عامة، يتعلق او لا يتعلق بالنظام العام، ليس بالامر السهل في كل الاحوال. وهو يكون سهلا اذا ما نص القانون على ذلك.
ويظهر إن المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية اعتبر جميع الاجال المنصوص عليها في هذا القانون هي آجال تتعلق بالنظام العام، حينما نص على الزامية احترامها والا سقط الحق. على العكس من ذلك فان المشرع في ظهير العقود والالتزامات لم يعتبر مدد التقادم من النظام العام إذ نص صراحة في الفصل 372 منه على : ” التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون، بل لابد لمن له مصلحة فيه ان يحتج به، وليس للقاضي ان يستند الى التقادم من تلقاء بنفسه“، وهذا وجه من أوجه الفرق بين مدد التقادم ومدد السقوط.
وجدير بالذكر، إنه يجب الحكم بالسقوط عند مخالفة الآجال المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية، بصرف النظر عن تحقق الغاية من الميعاد الزمني أو عدم تحققه، ذلك أن الغاية قدرها المشرع وربطها بأجل معين، وعدم مراعاة الأجل المحدد بمقتضى القانون يؤدي حتما إلى تخلف هذه الغاية كما أراد المشرع. كما لا يهم أن يكون الأجل جوهريا أو غير جوهري، متعلقا بالنظام العام أو غير متعلق به، فالغرض أن الغاية تتخلف بعدم احترام الميعاد أو الترتيب الزمني المحدد في نصوص القانون، وعليه، وجزاء لسقوط هو جزاء حتمي، لا يجوز القيام بالعمل بعد ذلك بإجراءات جديدة، ومن باب أولى لا يجوز تصحيحه بالتكملة؛ إلا إذا نص المشرع على جزاء آخر غير السقوط، فعندئذ يكون المشرع قد أوضح إرادته في عدم ترتيب جزاء السقوط في هذه الحالة.
[7] – والاجال التي ضربها القانون كثيرة العدد مختلفة المدد، لانها واجبة لتحضير الموضوعات واجراء التحقيقات، فلا يؤخذ أحد على حين غرة في تقرير حقوقه أو دفاعه عنها، وعلى هذا، فبالاضافة إلى الأجل المسقط هناك الاجل الكامل والاجل المحدود والاجل الناقص والاجل المرتد واجل المسافة والاجل الاستنهاضي وغيرها من انواع الاجال الاخرى …. ولا يهمنا هنا سوى النوع الأول، باعتباره المرتبط بوجوب مباشرة الحقوق تحت طائلة السقوط.
[8] – للتوسع في هذه النقطة يراجع :
سعيد الدغيمر، وقف التقادم وقطعه، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، تحت إشراف الدكتو مأمون الكزبري، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط 1980 ص 16 وما يليها.
[9] – Difour Mantelle « La force majeure dans les contrats civils ou comerciaux et dans les marchés administratifs ». Paris 1920. P :12.
[10] – B.Stark « Essai d’une théorie générale de la responsabilité civils considérée dans sa double fonction de gantie et de peine ». Thése . Paris 1947. n 243.
[11] – أحكام الأحكام على تحفة الحكام للعلامة ابن عاصم الأندلسي. شرح وتعليق مأمون بن محيي الدين الجنان. دار الكتب العلمية/ بيروت لبنان. ص. 142- 143.
[12] – الطعن رقم 3168 لسنة 68 قضائية جلسة 01-11-2012.
[13] – الطعن رقم 12089 لسنة 81 قضائية الدوائر المدنية، جلسة 03-05-2012.
[14] – الطعن 2564 لسنة 81 قضائية الدوائر العمالية، 18-11-2013.