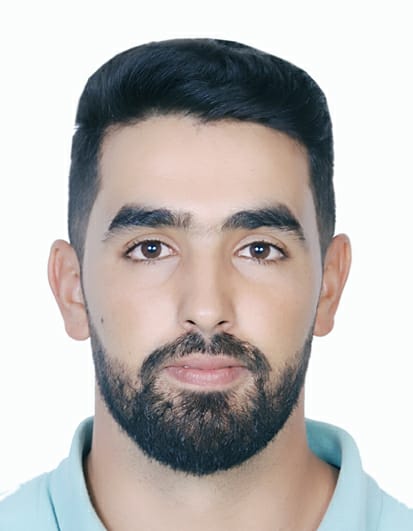“عصام الأشهب”، يكتب حول: “النظام العام والقضاء”
المعلومة القانونية
*عصام الأشهب
- باحث بسلك ماستر العلوم الأمنية وتدبير المخاطر بكلية الحقوق سطات
مقدمة
فكرة النظام العام من الافكار النسبية التي تتصف بالعمومية ، على اعتبار انها تسود جميع فروع القانون و تلعب دورا ذا اهمية بالغة في النظام القانوني بأكمله ، فالتطبيقات التي تجريها القوانين لهذه الفكرة تختلف باختلاف ماهية و طبيعة كل فرع من فروع هذه القوانين و الغرض الذي شرعت من اجله [1].
فاتساع نطاقها جعل الفقه يواجه صعوبة في تحديد مفهومها ونطاقه حدودها مما جعل تحديد مفهوم النظام العام غير تابت و غير موحد ود حتى الان ، انما حاولو تقريب معناه فقط الى الادهان و وجدو اساسه هو فكرة المصلحة العامة ، مهما كانت هده المصلحة سياسيه او اجتماعية او اقتصادية [2] .
أي ان فكرة تعريف النظام العام يقصد بمجموع المصالح الاساسية للجماعة ، أي الاسس و الدعامات التي يقوم عليها بناء الجماعة و كيانها ، بحيث لا يتصور بقاء هذا الكيان سليما دون استقراره عليها ، و لذلك كانت القواعد القانونية متعلقة بالمصالح الاساسية للجماعة أي متعلقة بالنظام العام ، قواعد امرة لا تملك الارادة الفردية أي سلطان او قدرة على مخالفتها ،اذا تعرض مخالفتها كيان المجتمع نفسه لانهيار و التصدع ، فلا يسمح لاي كان بان تجري ارادته على خلافها [3] .
ورغم كل هذا تبقى فكرة النظام العام فكرة مستعصية الضبط والتحديد ، كونها فكرة متطورة غير جامدة ، فترك امر تقديرها الى القاضي الذي يجب عليه التقييد بما هو سائر في الجماعة أو ما يمليه العقل الاجتماعي في زمان ومكان معين باعتباره الضمير العام للجماعة ولا يكون اعمالها وفقا لإرادة الخاصة .
حيث يمكن اعتبر فكرة النظام العام سلاح يتسلح به القاضي في مواجهة الحالات الغير متوقعة ومستبعدة من تطبيق القانون [4] .
لكن اذا كان القضاء دور مهم في تحديد و انشاء فكرة النظام العام ، فان لهذه الاخير اكتر فعالية في سير مرفق القضاء في حد ذاته ، خاصة في ما يتعلق بالجانب الاجرائي .
ولما كان موضوع البحث هو النظام العام و القضاء فان الامر يستدعي البحت عن دور القاضي في تحديد مفهوم النظام العام و دوره في الحفاظ عليه. وذلك من حلال مبحثين :
المبحث الاول : دور القضاء في تحديد مفهوم النظام العام
المبحث الثاني : دور القضاء و في الحفاظ النظام العام
المبحث الاول : دور القضاء و في تحديد محتوى النظام العام
ينص الفصل 110 من الدستور الجديد للملكة انه “لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون ، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون” [5]،إضافة للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، والذي ينص بدوره أنه يجب على ” القاضي خاصة أو المحكمة عامة أن تبت في حدود الطلبات ولا يسوغ أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات “[6].
من خلال قراءة هديين الفصلين يتضح ان دور الاعتيادي القاضي هو الفصل في النزاعات اعتماداً على القانون السائد في البلد ، الا انه يمكن ان تتعدى مهمته تطبيق النصوص الجامدة في القانون عندما يتعلق الامر بالنظام العام .
فالقاضي يتملك اساسا قانونيا سيبيح له تحديد محتوى النظام العلم لأنه تقع على عاتقه مسؤولية الدفاع عن المبادئ الاساسية التي يقوم عليها المجتمع الذي يحكم فيه .
من اجل هذه الغاية يتوجب على القاضي ان يكون مجتهد في البحث فيما وراء النصوص و القواعد التشريعية ، مستلهما روح التشريع و معناها ، وما هي السياسة التشريعية و الغاية التي ارادها المشرع من تشريع المبادئ و القواعد ، ففي الغالب ما تكون علة الحكم خارج منطوق النص من اجل تحقيق المصلحة العامة والعدل الذي ارادها الشارع من تشريعه .
و هدا يعني ان محتوى النظام العام لا يحدده فقط التشريع ، و انما يقوم ايضا بتحديده القضاء في حالت التي يغيب فيها النص على عتبار القاعدة موضوع النزاع هي من النظام العام أو في حالة غياب القاعدة كليا ، حيث ان هناك توافق على ان مناك مصادر اخرى للنظام العام غير القانون[7]
الامر الذي افرز اتجاهين فقهيين ، الاول يؤمن بقدسية النص و يرى ان النظام العام لا يمكن ان يكون مستقلا او معاكس للقانون ، هذا الاتجاه تزعمه الفقيه الفرنسي بنتام الذي امن بفضائل القانون المكتوب ، ان الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها تنجيب التشريع القضائي ، و اضهر عداؤه للشكوك التي يلقها صنع القانون من قبل القضاء[8] ،فهذه الطريقة في صنع القانون تعطي المجال للمكلفين باتيان اعمال غير مرغوب فيها بدون ان يكونو على علم بان هذه الاعمال تمثل انحرافات سلوكية يعاقب عليها القانون ، فقانون القضاء لا يظهر الا بعد اتيان المخالفة ،و ينحصر دور القضاء بهذه الحالة على معاقبة هده الافعال و هذا بخلاف النصوص المكتوبة التي هي من صنع المشرع فهي تنبه المخاطبين بها بعدم مخالفتها ، وفي حالت مخالفتها تفرض عليهم العقوبة المنصوص عليها في القانون الذي هو من صنع المشرع يفرض المخالفة و العقوبة معا ، فيكون المخاطبون بها على علم مسبق .
بناء على ما سبق يمنع على القاضي ان يقوم بابطال أي تصرف بحجة مخالفته للنظام العام ، الا اذا نص المشرع صراحة على منع متل هدا التصرف لارتباطه بالنظام العام ، فالنصوص التشريعية المتصلة بالنظام العام جاءت على سبيل الاستتثناء لا يجوز ان يتوسع فيها ، فالقانون وحدة هو الدي يحدد ان النص امر متعلق بالنظام العام ام انه اختياري ، لانه حسب هذا المنظور ،ترك مجال تحديد محتوى النظام العام للقاضي ، من شانه ان يعطيه صلاحيات يخشى ام تكون اداة لتعسف القضاء ، كما يشكل خرق لمبدا الفصل السلطات ، باعتبار ان القاضي في هده الحالة ياخد دور المشرع [9]
اما الاتجاه الثاني يرى ان القضاء يحضا بدور مهم في صناعة القانون ، هذا الدور الذي يهدف الى معرفة المفاهيم العامة للنظام العام و الاداب العامة التي يحدد القانون محتواها ، حتى ان الامر وصل الى حد القول بان النظام العام لا يوجد الا خارج القوانين الامرة ، وبالتالي فان القاضي هو الذي يقع على عاتقه ماهو مشروع و مطابق للنظام العام ، وما هو غير مشروع لمخالته لمقتضيات النظام العام و دلك في الحالات التي لا ينص القانون عليها [10] .
و في هدا الصدد اقرت محكمة النقد الفرنسية باستقلال النظام العام عن النص القانوني ، في صدد التعليق على المادة 1133 من مدونة القانون المدني الفرنسي حيث اكدت ” ان السبب هو غير مشروع عندما يكون مناقضا للنظام العام بدون ان يكون من الظروري ان يحظره القانون [11].
كما ان الفقيه” مورنديار” اعتبر ان النظام العام بالاصل ليس مفهوم تشريعي ، الان القانون يعتبر معيارا غير دقيق لتديد محتواه ، كذلك النظام العام مستقل عن التشريع ، وبناء عليه لا يكون ضروريا معرفة ما ادا كانت القاعدة القانونية مخالفة للنظام العام ام لا ،و لكن هو معرفة ما اذا كان التصرف القانوني مخالفا للنظام العام ام لا ، لان ذلك يعطي مفهوم النظام العام طابعا نسبيا واقعيا يعطي دورا القاضي دورا ضروريا في تحديد نطاقه [12] .
الا ان هذا الدور الذي الدي يقوم به القاضي المدني يختلف كليا عن الدور الذي يقوم به القام به القاضي الجنائي من حيث نطاق و محتوى النظام العام و حسن الادب ، فالقاضي المدني يقوم بدور ايجابي بهدا الصدد ، فهو يكشف عن النظام العام و لاداب العامة من خلال ما يقضي به شعور الجماعة و مدى مخالفة التصرف الذي قام به الشخص للقيم الاخلاقية في المجتمع ، اضافة الى انه ملزم بتسبيب حكمه اد كان مخالفا لحكم محكمة اخرى في دعوى مشابهة ، اما القاضي الجنائي فانه يكون ملوما بالمبدأ القاضي بان لا جريمة ولا عقوبة الا بنص القانون ، حيث ينحصر تقديره للنظام العام و الاداب من خلال جريمة جنائية [13] .
كما ان النظام العام و الاداب العامة امر مستقل عن مخالفة القاعدة القانونية ، وهذا يؤدي حتما الى استقلال فكرة النظام العام و الاداب عن نصوص القانون ، مما يحتم بالضرورة تحديد مضمونها وما هو المقصود منها حتى يمكن تطبيقها ، حيث ان فكرة النظام العام و الاداب لا يمكن ان تكون مرتبطة في وجودها بنوص قانونية تكرسها .
والدور الذي يقوم به القاضي هو من قبيل الرقابة الاجتماعية على القانون تجري من خلال عملية فحص او قبول او رفض المصالح المتنافسة ، الان وظيفة المحاكم باعتبارها الوكيل الاسمى للقانون فرض الرقابة الاجتماعية .
حيث يترك للقاضي مهمة تفسير القيم و الافكار و فلسفة الجماعة من خلال الروح السائدة في المجتمع ، الامر الذي يفضي الى اعتبار القاضي مشرعا او يكاد يكون مشرع في هذه الدائرة المرنة التي تسمح له بالتقييد بأولويات و مصالح امته [14]
باعتبار ان فكرة النظام العام تنتمي الى نطاق التفسير الذي يتولاه القضاء ، فيجب ان يكونوا على درجة عالية من الوعي و الادراك بالخصائص السياسية ، لفكرة القانون كما هي في الجماعة ، بل ان القاضي يعي و يدرك الضمير الكامن للقانون في مجتمعه وروح هذا القانون إلا هو النظام العام .
المبحث الثاني : دور القضاء في الحفاظ على النظام العام
يبرز دور القضاء في المحافظة على النظام العام من خلال رقابة القضاء الإداري لأعمال الشرطة الإدارية وفحص مدى توفيقها بين حفاظ النظام العام وحماية الحقوق والحريات ، حيث تنصب رقابة القضاء الإداري على اعمال الشرطة الادارية عندما تتدخل بشكل وقائي للحفاظ على النظام العام و الحيلولة دون الاخلال به ، بشتى وسائل القانونية التي تتدخل بها الشرطة الادارية للتدخل للحفاظ على النظام العام كالقرارات الادارية او التنظيمية أو الفردية او اعلى شكل جزاء الاداري .
ذلك من خلال البحث في الوقائع والأسباب التي دفعت الشرطة الإدارية إلى التدخل ، وفحص مدى جدية تلك الأسباب ، ومدى تهديدها فعلا للنظام العام ، وفحص مدى التناسب بين الهدف المتوخى والوسائل المستعملة ، بحيث لا تكون هذه الأخيرة مشروعة إلا إذا كانت تتناسب وخطورة التهديد التي اقتضى التدخل .
كما يراقب القاضي الإداري شكليات أخرى مثل الاختصاص ، الشكل ، المحل ، ومخالفة القواعد القانونية من عدمها .
وفي هدا الصدد يمكن ادراج مجموعة من الاجتهادات القضائية صدرت و خاصة في المجال الاداري .
ففي اجتهاذ للمحكمة الإدارية بالرباط في حكمها ألاستئنافي الخاص بمحضر 20 يوليوز[15]، “وحيث إنه استنادا إلى ذلك فإن المحضر الصادر بتاريخ 20/07/2011 يكون فاقدا لقوته الإلزامية لتحقق مخالفته للقانون ساري المفعول إبان توقيعه ، ذلك أنه لئن استند المدعي إلى قانون الالتزامات والعقود تأسيسا على إلزامية المحضر ، فإن القانون المذكور نفسه يجعل في فصله 62 الالتزامات التي يكون محلها مخالفا للقانون أو النظام العام في حكم العدم ، وعليه يبطل كل التزام منصب على القيام بتوظيفات عبر مساطر مخالفة للقانون ، لئن كان الجهاز الإداري عبر رئيسه المتمثل في الوزير الأول آنذاك يبقى هو الآخر ملزما بالخضوع لمقتضياته باعتباره التعبير الأسمى عن إرادة الأمة ، ولذلك لا يمكن للإدارة بإرادتها المنفردة أن تمنح حقا أو تسحبه خرقا للتشريعات الجاري بها العمل ، ولا أن توقع التزاما أو تتحلل منه إلا وفقا لما قرره القانون بمختلف مراتبه ، وأنه لئن كان الوزير الأول آنذاك قد أصدر مرسوما بتاريخ 08/04/2011 ينظم فيه مساطر التوظيف المباشر بشكل استثنائي ، فإنه لا يصح اعتماده أساسا لتوقيع المحضر المستدل به ما دام أن السلطة التشريعية قد أصدرت بعد ذلك قانونا سابقا على تاريخ المحضر المذكور ، يجعل التوظيف وفقا للمساطر الواردة بالمرسوم غير ممكن”.
من هنا يتضح ، ان القضاء قد عبّر على توجه حاسم ، مفاده جعل النص القانوني كأفق لا يمكن تخطيه وإن مس بالعدالة الإدارية ؛ التي يفترض أن تكون الغاية التي يضعها القاضي امام عينيه. فاحترام فكرة تدرج القانون باعتبارها أساس الدولة القانونية تعتبر من النظام العام .
وفي قرار اخر الاستئنافية الرباط المتعلق بحزب الأمة بتاريخ 29 نونبر 2012 [16]، وقضت من خلاله بإلغاء إجراءات إنشاء الحزب وحقه في التواجد ، ورفضت بالتالي التصريح له بالتأسيس . ففي هذا الحكم اعتمد القاضي الإداري بشكل كبير على سلطته في الملائمة ، حيث بحث عن قصور مسطري في إجراءات التأسيس ؛ مع العلم ، أن الحكم المتعلق بحل الحزب الأمازيغي[17]، استندت فيه المحكمة على منهجية تأويلية أوسع لأدوار الحزب السياسي ، مركزة على المرجعية الحقوقية المانعة من تأسيس الحزب على أساس عرقي أو على منطق الأقلية.
وهكذا اعتبرت “تركيز الحزب المدعي على فئة من المواطنين دون سواهم ، استنادا على أساس لغوي أو عرقي ينطوي على دعوة صريحة إلى تجزيء المجتمع والنيل من اندماجه وتلاحمه ، والحال أن الأحزاب السياسية مدعوة إلى تعبئة جهود وطاقات جميع مكونات المجتمع وقواه الحية لرفع التحديات الداخلية والخارجية للبلاد عن طريق تفعيل المواطنة الايجابية بهدف تحصين المسار الديمقراطي في المجتمع يشيع الحرية والمساواة. كما أن أسس الحزب وأهدافه كما هي موسومة في برنامجه السياسي توحي ؛ أن هناك فصل بين المكونات البشرية للمجتمع ، والحال أن الدستور المغربي يؤكد مبدأ المساواة المواطنين أمام القانون ، ومن تم فإن المواطنة من خلال رابطة الجنسية هي التي تحدد الحقوق والتزامات الجميع ، وليس هناك أي نص تشريعي أو تنظيمي يعتبر تمييزا سلبيا تجاه أي أحد من المواطنين بسبب دينه أو عرقه أو لغته أو توجهاته ، مما يجعل ما تمسك به الحزب في غير محله لعدم وجود مفهوم الأقليات في بنية المجتمع المغربي بالشكل الذي تحدده الاتفاقيات والمعاهدات الدولية”.
إن التأويل المفتوح على ضوء المبادئ العامة للقانون والمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية ، أدى في المحصلة ، للنتيجة نفسها في حالة حزب الأمة ، ومعنى هذا أن الدعاوى المتعلقة بالأحزاب السياسية يتم تناولها بحذر أكبر. إن تأسيس حزب سياسي جديد ليس حدثا عاديا ، بل يُغيِّر في الخريطة التمثيلية ، ويمس بذلك باستقرار التوازنات الاجتماعية . مما يجعلنا نقتنع بأن القاضي الإداري ينطلق من جواب جاهز لمثل هذه النوازل ، وبعد ذلك يبحث عن المصَوِّغات التي تُسعفه ؛ ولو اقتضى الأمر البحث عن ثغرات قانونية شكلية ؛ لا تؤثر على المسطرة العامة لتأسيس الأحزاب،كما هو الحال بالنسبة لحزب الأمة ، بل تضيق من مجال الحرية العامة والذي يفترض في القاضي الإداري الحامي الأول لها، أو اللجوء المكثف للحجاج الحقوقي من أجل بلوغ النتيجة المحددّة سلفا ، كما هو الحال بالنسبة للحزب الأمازيغي.
وفي حكم آخر، ذهبت المحكمة الإدارية بالرباط في إطار القضاء الاستعجالي[18] إلى اعتبار ” أن الإدارة لم تفصح عن الأسباب الداعية لإصدار القرار المطعون فيه كتابة ولم تمكن الطاعنة أو تدل للمحكمة بأي قرار مكتوب يتضمن العناصر التي ارتكز عليها ،ويبقى ما تمسكت به من اندراج القرار المذكور ضمن نطاق القرارات التي يقتضي الأمن الداخلي والخارجي للدولة هي من النظام العام يجوز عدم تعليلها ، غير ذي أساس، ما دام أنها لم توضح وجه التهديد الذي يطال الأمن الداخلي أو الخارجي نتيجة الإفصاح عن أسباب قرار عدم تجديد بطاقة الإقامة ، حتى تتبين المحكمة من سلامة ما سارت عليه الإدارة من عدم التعليل ، على أساس أن القرارات الصادرة في إطار رفض الترخيص بإقامة الأجانب وإن كانت غايتها حماية النظام العام”.
فالملاحظ في هذه النازلة، أن القاضي الإداري رفض فكرة تحصين القرار الإداري بحجة الأمن الداخلي والخارجي للدولة ، مطالبا الإدارة بتوضيح هواجسها المانعة من تمكين الطاعنة من تجديد إقامتها. فالقاضي الإداري أخذ على عاتقه تقدير مجال وحدود النظام العام ، وهذه المهمة لا تخلو من صعوبة ومن مواجهة واضحة للإدارة، والتي استغلت مسألة إمكانية عدم التعليل عندما يتعلق الأمر بالمساس بالنظام العام.
وهكذا، يستفاد أن هناك خيط ناظم لهذه الأحكام القضائية ، حيث سعت دائما إلى توسيع نطاق رقابتها على القرار الصادر في المجال الإداري ، بغض الطرف عن الجهة المصدرة للقرا ر، في اطار الحفاظ على النظام العام .
خلاصة
فكرة النظام العام هي تعبير عن الخطة السياسية المتبعة من الدولة لتحقيق النظام الاجتماعي التي ترغب فيه ، حيت يسخر المشرع نظامه القانوني لحمايتها لهذا يتوجب على القاضي ان يكون على اتصال وثيق بجوهر النظام الذاخلي للمجتمع ، و على علم واسع بحيثيات و فلسفة القانون الذي يحكم فيه و على الاطلاع عميق على نبض المجتمع الذي يعيش فيه حتى لا يقع في تناقض بين نمط التقافة المجتمع و بين القانون الذي الذي سنه المشؤع والحكم الذي يصدره القاضي ،
و لا ينحصر دور القاضي في تطبيق النصوص الجامدة و انما تتمثل دوره في احقاق الحق و تحقيق العدل و العدالة فهو يمتلك اساسا قانونيا يسمح له بتحديد محتوى النظام العام ، ألانه غاص في اعماق القانون ، فتقع على عاتقه مسؤولية الدفاع عن المبادئ الاساسية التي يقوم عليها المجتمع في احكامه.
وكما لا يجب اغفال الدور المهم للقضاء في تحديد محتوى النظام العام في حالت النقص التشريع او غياب النص من خلال اعمال سلطة الملائمة ,
لائحة المراجع
مراجع باللغة العربية
ـ العديب ،محمد عبد ،النظام العام في العقود المدنية و مدى الحماية التي يكفلها له القانون الجنائي في مجال الانعقاد و التنفيد 2005 بدون دار النشر
ــ محمد صالح الخرار ، المفهوم القانوني لفكرة النظام العام ، مجلة دراسات القانونية ، العدد 6 الجزائر 2003
ــ كيره ، حسن المدخل الى القانون ، القانون بوجه عام ، النظرية العامة للقواعد القانونية ، النظرية العامة للحق مشاة المعارف بالإسكندرية
ــ غستان جاك، المطول في القانون المدني تكوين العقد ، ترجمة منصور القاضي ، مراجع فيصل كلثوم الطبعة الثانية ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع 2008
ــ لويد دينيس ، فكرة القانون ، تعريب المحامي سليم الصويص ، مراجعة سليم بسيسو 1981 م ، علم المعرفة ، الكويت
ــ المهذبي ،روضة ، مفهوم النظام العام في تكوين العقد ، رسالة للاحراز على شهادة الدراسات المتعمقة في القانون الخاص ، اشراف عماد العربي ـ جامعة المنار ، كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس ، السنة الجامعية 2002 ـ2003
ــ الغريب محمد عيد ، النظام العام في العقود المدنية و مدى الحماية التي يكفلها القانون الجنائي في مجال الانعقاد و التنفيذ ، 2005 بدون دار النشر ، ص 284 ــ 285 بند 161
[1] السنوهري عبد الرزاق احمد ، الوسيط في شرح القانون المدني الحديث الجزء الثامن ، حق الملكية مع شرح مفصل للاشياء و الاموال الطبعة الثالثة الجديدة ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 2000
المراجع باللغة الفرنسية
ـC.F .MOHAMD ISSAD ; Droit intrnational peivé ;tome 1 Les régle de conflite op.u 1986
القوانين
ــ نص الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011. ج.ر عدد: 5964 مكرر الصادر بتاريخ 30 يوليوز 2011.
ــ قانون المسطرة المدنية ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 الموافق ل28 شتنبر 1974 كما تم تتميمه وتعديله.عن موقع وزارة العدل والحريات الرسمي قانون المسطرة المدنية الصيغة المحينة بتاريخ 20 مارس 2014.
احكام و قرارات قضائية
ــ حكم المحكمة الإدارية بالرباط، رقم: 898 ،ملف عدد: 2015/7112/، الصادر بتاريخ 26 فبراير 2016 ،غير منشور.
ــ محكمة الاستئناف الإدارية قرار عدد 4736 بتاريخ 29 نونبر 2012.غير منشور.
ــ حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 637 بتاريخ 17 فبراير 2008، بين وزير الداخلية ضد الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، اورده يونس الشامخي” تطور المرجعية الكونية في الاجتهاد القضائي الإداري المغربي” مجلة الأنظمة القانونية والسياسية،العدد العاشر،أكتوبر 2016
ــ المحكمة الإدارية بالرباط، القضاء الاستعجالي،ملف رقم:3026/7101/2013 أمر رقم:2917،بتلريخ،05 غشت 2016،غير منشور.
[1] العديب ،محمد عبد ،النظام العام في العقود المدنية و مدى الحماية التي يكفلها له القانون الجنائي في مجال الانعقاد و التنفيد 2005 بدون دار النشر ص5
[2] محمد صالح الخرار ، المفهوم القانوني لفكرة النظام العام ، مجلة دراسات القانونية ، العدد 6 الجزائر 2003 ص 32
[3] كيره ، حسن المدخل الى القانون ، القانون بوجه عام ، النظرية العامة للقواعد القانونية ، النظرية العامة للحق مشاة المعارف بالإسكندرية
[4] C.F .MOHAMD ISSAD ; Droit intrnational peivé ;tome 1 Les régle de conflite op.u 1986 P204
[5] الفصل 110 من نص الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011. ج.ر عدد: 5964 مكرر الصادر بتاريخ 30 يوليوز 2011.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية تبنت دستور 2011 بعد التطورات الموضوعية التي عرفها النظام السياسي وبنية الدولة خاصة مع ما يعرف بالحراك الشعبي ل20 فبراير 2011، وقد جاء هذا الدستور بإمكانيات جديدة خاصة فيما يعلق باستقلال السلطة القضائية التي ظلت مجرد جهاز تابع للسلطة التنفيذية في ظل الدساتير السابقة للملكة خاصة دستور 1996. ويمكن تلمس هذا التحول من خلال الباب السابع في الفصل 107.
[6] الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 الموافق ل28 شتنبر 1974 كما تم تتميمه وتعديله.عن موقع وزارة العدل والحريات الرسمي قانون المسطرة المدنية الصيغة المحينة بتاريخ 20 مارس 2014.
[7] غستان جاك، المطول في القانون المدني تكوين العقد ، ترجمة منصور القاضي ، مراجع فيصل كلثوم الطبعة الثانية ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع 2008 ص 133
[8] لويد دينيس ، فكرة القانون ، تعريب المحامي سليم الصويص ، مراجعة سليم بسيسو 1981 م ، علم المعرفة ، الكويت ،ص 309
[9] المهذبي ،روضة ، مفهوم النظام العام في تكوين العقد ، رسالة للاحراز على شهادة الدراسات المتعمقة في القانون الخاص ، اشراف عماد العربي ـ جامعة المنار ، كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس ، السنة الجامعية 2002 ـ2003 ص 34
[10] غستان جاك ، مرجع سابق ص 35
[11] غستان جاك ، مرجع سابق ص 116
[12] المهذبي، روضة ،مرجع سابق ، ص 35
[13] الغريب محمد عيد ، النظام العام في العقود المدنية و مدى الحماية التي يكفلها القانون الجنائي في مجال الانعقاد و التنفيذ ، 2005 بدون دار النشر ، ص 284 ــ 285 بند 161
[14] السنوهري عبد الرزاق احمد ، الوسيط في شرح القانون المدني الحديث الجزء الثامن ، حق الملكية مع شرح مفصل للاشياء و الاموال الطبعة الثالثة الجديدة ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 2000 ص 437
[15] حكم المحكمة الإدارية بالرباط، رقم: 898 ،ملف عدد: 2015/7112/، الصادر بتاريخ 26 فبراير 2016 ،غير منشور.
[16] محكمة الاستئناف الإدارية قرار عدد 4736 بتاريخ 29 نونبر 2012.غير منشور.
[17] حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 637 بتاريخ 17 فبراير 2008، بين وزير الداخلية ضد الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، اورده يونس الشامخي” تطور المرجعية الكونية في الاجتهاد القضائي الإداري المغربي” مجلة الأنظمة القانونية والسياسية،العدد العاشر،أكتوبر 2016،ص 8.
[18] المحكمة الإدارية بالرباط، القضاء الاستعجالي،ملف رقم:3026/7101/2013 أمر رقم:2917،بتلريخ،05 غشت 2016،غير منشور.